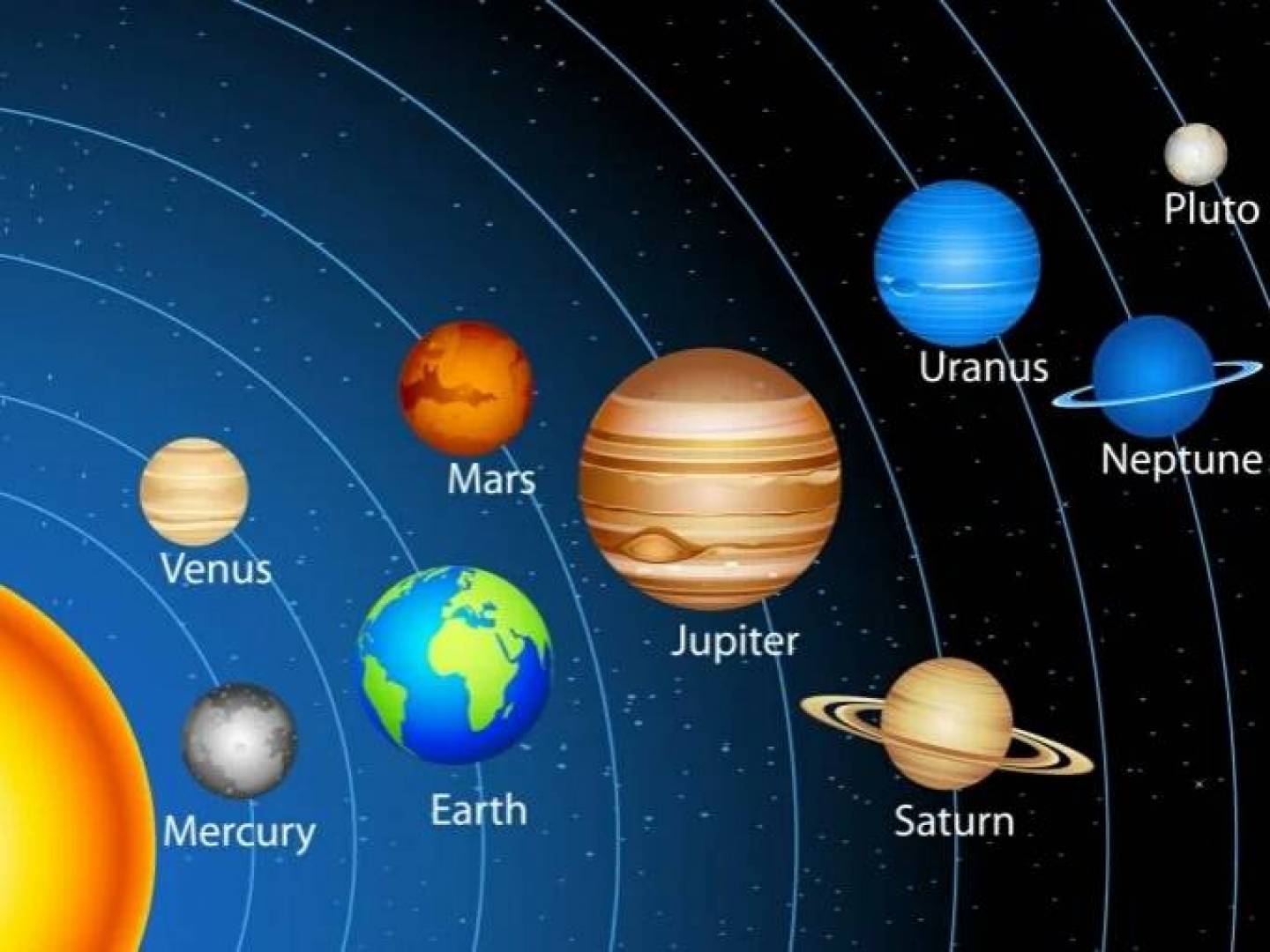د. مياده ابراهيم رزوق*
بقراءة معمّقة متأنية لخطاب الرئيس السوري بشار الأسد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في اجتماع اللجنة المركزية الموسعة نجد أنفسنا أمام مفكر ذي بصيرة ورؤية استراتيجية، قرأ الواقع العربي بشكل عام والسوري بشكل خاص، لينطلق ببناء المفاهيم وشرح المصطلحات بما ينسجم مع الواقع ويحقق النهوض الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدولة السورية بعد وضع منهج ورسم السياسات الاستراتيجية الشاملة من قبل حزب البعث العربي الاشتراكي كحزب حاكم بقوة صندوق الاقتراع لتطبيق الخطط والرؤى بشكل ميداني.
أدرَك الرئيس الأسد بعد الحرب الكونية على سورية وما تركته من آثار سلبية على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سورية بما فيها البنية التنظيمية لحزب البعث العربي الاشتراكي، وتدني الحالة الفكرية للكوادر البعثية، أهمية عودة دور البعث كحزب عقائدي ببناء الدولة السورية مستنداً إلى:
1 ـ دوره التاريخي كلاعب ومحرك أساسي على الساحة السياسية السورية منذ الاستقلال بدءاً بالمواجهة السياسية لحلف بغداد، والاخوان المسلمين في خمسينيات القرن الماضي، وإلى دوره في الوحدة مع مصر، ولاحقاً مواجهة الانفصال وصولاً إلى قيادة ثورة 8 آذار عام 1963 وبعدها مرحلة ما بعد الحركة التصحيحية وإنشاء البنية التحتية الكبيرة، ثم المواجهة السياسية والعسكرية لعصابات الإخوان المسلمين مرة أخرى في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات وصولاً إلى الحرب الحالية وما قدّمه الحزب من شهداء واحتضان للقوات المسلحة منذ سبعينيات القرن الماضي.
2 ـ انطلاقه كحزب قومي عربي من انتماء اجتماعي حقيقي تاريخي واقعي، أتبع ذلك بنظريات تؤطر هذا الانتماء وتعطيه بعداً فكرياً يُعزز وحدة المجتمع ويقوّيه بعيداً عن الانتماءات الضيقة بهويات تحت وطنية.
لذلك بدأ الرئيس الأسد خطابه بالتأكيد على أهمية إعادة تموضع حزب البعث العربي الاشتراكي كحزب عقائدي في عصر الايديولوجيات، وزمن الحروب الثقافية وتشويه القيَم والمفاهيم وقلب المصطلحات، فأكد على ضرورة المواجهة ـ بعد تصحيح بنيته التنظيمية ـ بفكر وعقيدة واضحة تنطلق من فهم واقعي للمصطلحات بما ينسجم مع تطور المجتمع السوري وانفتاحه على العالم الآخر، ويحقق النهوض المجتمعي والاقتصادي، ويتوافق مع دور سورية الإقليمي وموقعها الجغرافي.
منتقلاً الى دور سورية الإقليمي في قلب محور المقاومة، ومؤكداً على ثوابتها ومواقفها المبدئية تجاه القضية والعدو (القضية الفلسطينية، والامبريالية العالمية) اللتين لم يتغيّرا، بل تغيّرت الأحداث بشكلها الخارجي، وبقيت مفاهيم السيادة والانتماء والدفاع عن أوطاننا دون تبعية أو خضوع هي عنوان كلّ مرحلة حتى النصر المبين.
وسنتناول في هذا المقال الشقّ الايديولوجي والعقائدي وإعادة قولبة المفاهيم بما ينسجم مع ديناميكية المجتمع وتطوره، فقد اعتبر الرئيس الأسد أنه يجب البحث في عمق الهوية لأنّ الأطراف المعادية تحاول أن تستهدف الهوية والانتماء، فالغرب وضع جيل الشباب أمام خيارين، الأول أن يكون متطرفاً دينياً، والثاني أن يكون منحلاً وفاقداً لأيّ انتماء وأخلاق، لذلك فإنّ التحدي أمام دولنا هو أن نخلق للجيل خياراً ثالثاً يقوم على أساس الحفاظ على الهوية والثقافة والانتماء، وبما يتناسب مع العصر الحالي بشكل يعبّر عن الاعتزاز بالدين والهوية والوطنية والثقافة الاجتماعية والحضارية، حيث أنّ شعوبنا عبر التاريخ دافعت عن هويتها وانتمائها وأخلاقها الحضارية التي جاء الدين ليتمّمها ويعززها.
ولا يمكن خلق الخيار الثالث دون التصدي للنازية الجديدة ونهج الليبرالية الجديدة التي عملت على تسويق مفاهيم ومصطلحات وأفكار تفتت المجتمعات وتعمل على هدمها.
فالليبرالية الجديدة بمعناها الايديولوجي مصطلح فضفاض ومفهوم زئبقي حمّال أوجه تلتقي في بوتقته كلّ التناقضات الحادة والصارخة، من الانفلات الكامل من النظم القيمية إلى التطرف الديني والإرهاب السياسي والعنف المسوغ تحت ستار حرية الفرد التي لا يضبطها قانون ولا تشذبها معايير أخلاقية أو إنسانية، وهذا المعنى المطاطي لليبرالية تكتنفه كلّ الالتباسات الفكرية لجهة ضبابية مقاصدها، والغموض الذي يغلّف النيات المفخخة والمآرب الملغمة لمروّجيها ومسوّقيها ودعاتها لغزو مجتمعاتنا من جهة، والأيدي الخفية التي تتحكم بكونترول توجيهها وتعويمها على سطح الدعايات المغرضة كمنهج ظاهره «ديمقراطي» ومضمونه تخريبي من جهة أخرى.
فالتسويق المحموم والمكثف والتجميل الدعائي «للنيوليبرالية» الذي يجري العمل على ترويجها كأفضل الطرق لرفاهية المجتمعات والأفراد لا تغيب عنها أصابع من يريدون إفراغ مجتمعاتنا من جوهر تماسكها وذخيرتها القيمية كروافع أساسية ضامنة لعدم تفكك المجتمع وتحصين منعته من الاختراقات التي يجهد لإحداثها صناع الإرهاب العالمي ومسوّقو الانحلال الخلقي والعنف، الذين لهم مصالح استعمارية وأطماع لا تحدّها حدود ولا يردعها قانون دولي.
وواهم من يعتقد أنّ الليبرالية ذات لبوس اقتصادي براق، وأنها تنحصر فقط في غزو فكري تخريبي هدام فقط، وإن كانت تحمل كل ذلك في ثناياها كخطوة أولى يتسلل من خلالها منظرو التخريب لإحداث ثغرات تنفذ منها لتبيح الرذائل والانعتاق من الضوابط الناظمة والرادعة التي تحمي حقوق الأفراد وتمنع التعديات، بل إنّ لها أيضاً وجهاً سياسياً وأحزاباً يجري تعويمها، ومنطلقات ينطلق من منصتها أولئك للسيطرة على المجتمع وسلطاته التشريعية وصولاً للحكم تحت شعارات كاذبة كالديمقراطية، وعبر دسّ سموم الحريات في طبخة الوصول إلى المناصب السياسية، وهنا يكمن الخطر الأكبر كون هؤلاء لا يهمّهم إلا مصالحهم وينفذون أجندات قوى إقليمية وعالمية تستخدمهم كطعم مسموم لتحقيق أهدافها الدنيئة.
فالليبرالية مجرد قناع بغيض للهيمنة الاستعمارية بكلّ أشكالها السياسية والاقتصادية وصولاً إلى واقع متوحّش لا يحتكم لأيّ قيمة إنسانية أو أخلاقية، بل يسوده قانون الغاب وتتحكم بسلوكيات دعاتها الانحراف عن سكة المصلحة الوطنية الجامعة والرغبة الجامحة للجشع غير المحدود ولو على حساب انهيار المجتمع وتدمير مقومات الدولة، وتتغلب فيه الأطماع على القيم والأخلاق.
إذن… الليبرالية ليست شعارات عابرة تختزل فقط بالترويج لحرية الفرد المنفلتة من عقال الضوابط القيمية ومن أيّ قوانين رادعة للتعديات على الآخرين، بل هي منظومة شرور هدامة كاملة فكرية واقتصادية وسياسية يجري العمل على تعويمها على سطح الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تمهيداً لتفريغ المجتمعات من مضامينها الإيجابية الخلاقة، وإتاحة مساحات واسعة للعبث الذي يريده أعداء الحضارات وصناع الخراب والحروب والفتن، هي أيديولوجيا متكاملة يعمل عليها منظرون وخبراء محترفون في التضليل والخداع النفسي وماكينات نفث سموم متواصلة بعضها ينفث سياسياً والآخر اقتصادياً وفكرياً، وصولاً إلى انسياق أفراد المجتمعات كقطعان معصوبة الإدراك والضمائر وراء الهدف الأساس من كل ذلك وهو هدم مجتمعاتهم بأيديهم.
وقد تناول السيد الرئيس بشار الأسد الليبرالية الجديدة وبشكل لاذع غير مرة وخاصة في أثناء حديثه معَ الدُّعاة في وزارة الأوقاف في عام 2020، مُؤكِّداً أنَّ سبل مواجهة الليبرالية الجديدة تتمثّل في تعزيز الهوية الوطنية والعروبة وتحصين الأجيال وترسيخ البنية المُجتمعيّة المناهضة للتحلُّل والانسلاخ من القيم والأخلاق، وهو ما تقوم عليه الليبرالية الجديدة، مُؤكِّداً ضرورة الحفاظ على القيم الفاضلة والروابط الأسريَّة والانتماء ومقاصد الدِّين والعقائد وأهدافها الاجتماعية.
وبالعودة إلى الليبرالية بشكلها الاقتصادي، وقد تناول الرئيس بشار الأسد مفهوم الاشتراكية بين الايديولوجيا والقواعد الاقتصادية، وبأنها نظرية وليست عقيدة، وأثار جدلاً كيف يمكن بلوغ نقطة التوازن بين الايديولوجي والاقتصادي؟
لقد أثار مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي الكثير من التساؤلات حول ما إذا كان هذا الانتقال تحوّلاً من الايديولوجيا الاشتراكية إلى الايديولوجيا الليبرالية أو الاقتصاد الليبرالي أيّ الاقتصاد الحر. كما ذهب البعض إلى حدّ المطالبة علناً بتعديل الدستور وإلغاء العبارة التي تنص على أنّ الاقتصاد في سورية هو اقتصاد اشتراكي مخطط. وكأنّ اقتصاد السوق الاجتماعي لا يمكن أن يطبق في ظلّ نظام اشتراكي.
في الحقيقة من الخطأ الاعتقاد بالتعارض ما بين اقتصاد السوق الاجتماعي والنظام الاشتراكي إذ إن الاشتراكية لم تعد فقط الملكية العامة أو الجماعية لرؤوس الأموال أيّ أدوات ووسائل الإنتاج. كما لم يكن يعني وجود قطاع عام في الدول الرأسمالية التحوّل باتجاه الاشتراكية فقد تملكت الدول الرأسمالية وسائل الإنتاج وأقامت العديد من المصانع والمشاريع الإنتاجية وليس فقط التدخل في النشاط الاقتصادي, وقد أطلق الاقتصاديون اليساريون على هذه المرحلة من تطور الرأسمالية تسمية رأسمالية الدولة الاحتكارية. لذلك من الخطأ الربط بين الملكية العامة والاشتراكية أو الربط ما بين اقتصاد السوق الاجتماعي والرأسمالية. كما أن كلاً من مفهوم الاشتراكية أو مفهوم الليبرالية الاقتصادية ليسا مفهومين ثابتين بل تعرّضا ـ شأنهما في ذلك شأن المفاهيم الأخرى ـ للتطور بتطور الفكر الإنساني ولا سيما السياسي والاقتصادي، بما يعتمد على المنافسة الحرة وآلية السوق التي تعتبر بمثابة آلية لتنظيم الفعالية الاقتصادية والصناعية.
فالمشكلة لا تكمن في الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي بحدّ ذاته وإنما الانتقال إلى اقتصاد السوق بالمعنى الليبرالي وما ينبثق عن هذا الانتقال من اتباع للسياسات الليبرالية ومن انسحاب للدولة من الحياة الاقتصادية وبالتالي تخليها عن دورها في الحماية الاجتماعية، وبالتالي التخلي عن الاشتراكية التي لم تعد الملكية العامة لوسائل الإنتاج والتخطيط المركزي وإنما تعني مذهب التضامن الاجتماعي وهي حالة وسطية ما بين الملكية العامة والملكية الخاصة لوسائل وأدوات الانتاج. ومذهب التضامن الاجتماعي لا يعترف بالمصلحة الفردية وتطابق هذه المصلحة مع المصلحة العامة أيّ إنّ سعي الأفراد وراء تحقيق مصالحهم، لا يحقق المصلحة العامة. بل يقوم على الاعتراف بالنوازع الاجتماعية للسلوك البشري لأنّ الفرد ليس حقيقة منفصلة عن الجماعة. وهو ما يسمّى اقتصاد السوق الاجتماعي أي التوفيق ما بين الملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية، ما بين المبادرات الفردية وتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية بما يضمن توجيه هذه المبادرات نحو ما يخدم المصلحة العامة أيّ الوطن, أيّ تحديد أنماط الفرد وسلوكه الاقتصادي وفقاً لحاجات الجماعة، لذلك فهو يفترض التكامل ما بين الفرد والدولة ولا يرى تعارضاً بينهما. لذلك فإنّ الاعتقاد بأنّ الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي هو إلغاء دور الدولة، هو اعتقاد خاطئ لأنّ دور الدولة لم يعد محلّ اختلاف فقد أصبح من المسلم به أهمية هذا الدور وإنما تغيّر شكل هذا الدور وذلك من خلال إعفاء الدولة من الأدوار التي كانت تضطلع بها في عقود الستينيات والسبعينات وحتى أواسط الثمانينيات من القرن المنصرم، وهذا الدور الجديد للدولة لا يعني التخلي مطلقاً عن مواجهة تحديات التنمية بل التأكيد على دور مختلف للدولة في تحقيق التنمية، فالدولة لها دور هامّ حتى في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي سواء على مستوى الوظيفة الكلية في ما يتعلق بالنمو والعملة والأسعار إلخ… أم في وظيفة البنية الأساسية من طرقات وجسور وسدود إلخ… أم في تنمية الموارد البشرية وتشمل التعليم والصحة والتغذية والإسكان إلخ… والوظيفة التشريعية من حيث النظام الضريبي والتشريعات الضريبية وتشريعات العمل إلخ… بما يضمن العدالة الاجتماعية والوظيفة الرقابية للدولة من حيث منع الاحتكار والاستغلال إلخ…
أما عن دور كل من القطاع العام والقطاع الخاص في ظلّ اقتصاد السوق الاجتماعي فليس المهمّ أنّ القطاع العام أفضل من القطاع الخاص أو العكس وإنما المهم تكامل عمل القطاعين معاً وكيف يمكن أن يعملا كشريكين في عملية التنمية وبالتالي انسحاب القطاع العام من الأنشطة الاقتصادية التي يجب تركها للقطاع الخاص وحصره في الأنشطة التي يعزف عنها القطاع الخاص.
ولقد أثبتت التجربة التاريخية في الكثير من الدول أنّ الدولة القوية والنشيطة في الحياة الاقتصادية شرط من شروط التنمية وهي السند في حماية المصالح الاقتصادية للمجتمع من منافسة الدول الأخرى.
وهنا لا بدّ من أن نستذكر الكلمة التي قالها القائد الخالد حافظ الأسد لرفاقه في القيادة القطرية ـ كما ورد في كتاب السيد العماد أول مصطفى طلاس (مرآة حياتي) ـ بعد أن جنحوا بالحزب إلى اليسارية الطفولية بعد حركة 23 شباط قال: إذا كانت الاشتراكية سوف تؤدّي إلى جوع الشعب يجب أن نعيد النظر في اشتراكيتنا. لذلك جاءت الحركة التصحيحية لتنادي بالتعددية السياسية والاقتصادية، حيث تجسّدت التعددية السياسية بالجبهة الوطنية التقدمية أما التعدّدية الاقتصادية فقد تجسّدت بتعدّد أشكال الملكية وذلك من خلال وجود قطاع عام وقطاع خاص وقطاع مشترك وقطاع تعاوني.
لذلك فإنّ الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي لا يعني التخلي عن الثوابت الوطنية أيّ الاشتراكية وتجربتنا الخاصة في الديمقراطية التي لا تعني لنا فقط حرية التعبير وكفالة الحريات الفردية كما ينادي دعاة الديمقراطية الليبرالية والاقتصاد الحر بها، وإنما هي حق المواطن في العمل والضمانات الاجتماعية من صحة وتعليم والمعيشة الإنسانية اللائقة.
ومن هنا تأتي أهمية إعادة تموضع دور حزب البعث العربي الاشتراكي كحزب عقائدي حاكم، يفعّل الحوار في مناقشة المصطلحات والأفكار والمفاهيم الأيديولوجية وتطور وسائلها وآلياتها بما ينسجم مع دينامية تطور المجتمع وعلى مختلف مستوى قياداته، نحو رسم السياسات الشاملة للدولة دون أن يغرق بالعمل الإجرائي اليومي الذي تقوم به الحكومة، لبناء الدولة السورية القوية الصلبة المنخرطة في عملية التنمية من خلال تعبئة كافة الجهود والكفاءات السورية، والقادرة على مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.
*باحثة وأكاديمية سورية