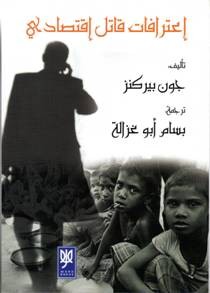كتاب القاتل الإقتصادي لجون بيركينز من أهم الكتب التي تفضح اساليب عصابات المال المتحكمة في العالم , الكتاب يفضح الأساليب القذرة التي قامت بها أجهزة المخابرات المختلفة لصالح العصابات الحاكمة لأمريكا, قام بترجمة القاتل الإقتصادي للعربية الشاعر والأديب بسام أبو غزالة
إضاءات
نبذة عن حياة جون بيركينز كاتب كتاب (القاتل الإقتصادي)
لقد بدأت ببراءة تامة.
ولدتُ عام 1945، وكنتُ الطفلَ الوحيدَ لأسرةٍ تنتمي للطبقة المتوسطة. وينحدر كلا والدَيّ من أولئك الأمريكيين الذين استوطنوا نيو إنكلاند لثلاثة قرون خلت. وكانا يتمسكان بعادات “الجمهوريين” الملتزمةِ بالحزم والاستقامةِ التي كانت انعكاسا لعادات أجيالٍ من السلف “البيوريتانيين” المتزمِّتين. وكانا في أسرتيهما أولَ من ابتُعِثا لتلقي التعليم العالي. شارك أبي في الحرب العالمية الثانية كملازم في سلاح البحرية، وكان آمراً للمجموعة البحرية المسؤولة عن الحراسة المسلحة على ظهر ناقلة نفط تجارية قابلةٍ للاشتعال الشديد في المحيط الأطلسي. يوم وُلدتُ في هَنُوفر، نيو هامبْشَيَر، كان أبي يتعافى من كسر في وِرْكِهِ في مستشفىً بتكساس، فلم أره حتى بلغتُ من عمري عاما.
عمل أبي مُدرِّساً للغات في مدرسة تِلتُن، وهي مدرسة داخلية للأولاد في ريف نيو هامبْشَيَر. كان حرم المدرسة مقاما على تلةٍ يُطلُّ من علٍ باعتزازٍ – أو بكبرياءَ، كما يزعم بعضُهم – على البلدةِ التي تحمل المدرسةُ اسمَها. وقد انحصر القبولُ في هذه المدرسة الخاصّةِ على خمسين تلميذا تقريباً في كل مرحلة دراسية، من الصف التاسع إلى الثاني عشر. وكان أغلبُ التلاميذِ من أبناء الأسر الغنية من بيونِس آيرس وكراكاس وبوسطن ونيويورك.
لم تكنْ أسرتي ميسورةَ الحال؛ ولكننا قطعاً لم نكن نعتبر أنفسنا فقراء. فبالرغم من ضآلةِ رواتبِ المُعلِّمين في المدرسة، فقد كانت حاجاتِنا كلَّها مؤمَّنةً: من طعام، ومسكن، وتدفئةٍ، وماء، وعمال لجزِّ المسطح الأخضر في حديقتنا ولإزاحة الثلج عن مدخل بيتنا. حين بلغتُ الرابعةَ من عمري، أخذتُ أتناول وجباتي الغذائية في غرفة طعام المدرسة التمهيدية، وألمُّ الكرات للاعبي كرة القدم الذين كان أبي يُدرِّبُهم، وأقدِّم المناشف في غرفة الغيار.
لعلّ القول إن المُعلِّمين وزوجاتِهم كانوا يستعلُون على أهل البلد قولٌ مُخَفِّفٌ من وطأة الحقيقة. فقد كنتُ أسمع والديَّ يتمازحان حول كونهما سيدي العزبة، ويحكمان على الفلاحين من أهل البلد، مُدركاً أنها أبعدُ من مجرد نكتة.
كان أصدقائي في المدرسة الابتدائية والمتوسطة من تلك الطبقة من الفلاحين الفقراءَ جدا، الذين كان آباؤهم مُزارعين متسخين، وحطّابين، وعمال مطاحن، يُضمرون حقداً على “أولاد الكلية فوق التل”. أما أبي وأمي، فقد كانا يُحذِّرانني من مخالطة بنات البلدة، اللواتي كانا يصفانهنّ بالساقطات. وكنتُ أتبادل الكتب المدرسية والأقلام مع هؤلاء البنات منذ صفِّي الأول، ووقعتُ في غرام ثلاثٍ منهن: آن وبريسِلاّ وجودي. وبالرغم من أنني استصعبتُ فهمَ وجهة نظر والديَّ، فقد أذعنتُ لرغبتيهما.
كنا نقضي ثلاثة شهور من عطلة أبي الصيفية في كوخ على البحيرة بناه جدّي عام 1921، مُحاطٍ بالغابات، حيث كنا نسمع في الليل أصوات البوم وأسود الجبل. لم يكن لنا هناك جيران، فكنتُ الطفلَ الوحيدَ ضمنَ مساحةٍ يُمكن قطعها مشيا. لذلك كنتُ أقضي وقتي في السنين الأولى متخيِّلا الأشجارَ فرسانَ الدائرة المستديرة، والفتاةَ المختطفة إما آن أو بريسِلاّ أو جودي (حسب السنة). وكانت عاطفتي، بلا شكٍّ، كمثل عاطفة لانسِلُتْ تجاه غْوينيفر – بل أكثر سريّة.
حين بلغتُ الرابعةَ عشرةَ مُنحتُ منحةً دراسيةً في مدرسة تِلتُن. وبناءً على ضغط والديَّ، تخلّيتُ عن كل علاقةٍ لي بالبلدة ولم أعدْ أرى أصدقائي القدامى. وحين كان أبناءُ صفي الجدد يعودون إلى ديارهم في العطلة، كنتُ أبقى وحدي على التل، فكانت صديقاتُهن جديداتٍ، بينما لم يكن لي صديقات، إذ أن الفتيات اللواتي كنتُ أعرفُهن كن “ساقطات”، فتخليتُ عنهن، وهنّ بدورهنّ نسينني. بلى، كنت وحيدا مُحبَطا.
كان والداي بارعين في التلاعب بالكلام؛ فقد أكّدا لي أنني كنتُ محظوظا بمثل تلك الفرصة التي سأكون ذات يوم ممتناً لنيلها. ولسوف أجدُ زوجة ممتازة تناسب مستوانا الخُلُقيََّ العالي. لكنني في داخلي كنت أغلي؛ فقد كنتُ تواقاً لصديقةٍ أنثى – وللجنس؛ و كثيراً جدا ما كانت تُغويني فكرة فتاةٍ ساقطة.
بيد أني، بدل التمرُّدِ، كبتُّ غُلوائي، مُعبِّراً عن إحباطي بالتفوُّق. فقد كنتُ في الدراسة على لائحة الشرف، ورئيساً لفريقين منتخَبيْن، ومحرِّراً لصحيفة المدرسة. كنتُ مُصمِّماً على أن أتميَّزَ على أبناء صفِّي الأغنياء وأن أترك ورائي تِلْتُنْ إلى الأبد. وقد مُنِحتُ بعثةً رياضيةً كاملة إلى براون، وأخرى دراسيةً إلى مِدِلْبَري. فاخترتُ براون لأنني فضّلتُ أن أكون رياضيا – ولأن موقعَها كان في مدينة. كانت أمي تخرجت من مِدِلْبَري، و من هناك أخذ أبي درجة المَجستير، لذلك فضّلا مِدِلْبَري، بالرغم من أنّ براوْن كانت عضوا في العصبة الجامعية (آيفي ليغ).
قال أبي: “ماذا لو أنّ ساقكَ انكسرت؟ أُفضِّلُ أن تأخذ المنحة المدرسية.” لذلك تنازلتُ عن رأيي.
لم تكنْ مِدِلْبَري، برأيي، إلا صورة منفوخةً لتِلْتُنْ – إلا أنها في ريف فيرمُنت بدل ريف نيوهامبْشَيَر. صحيح أنها كانت مختلَطة جنسيا، لكنني كنتُ فقيراً وكان معظمُ الآخرين أغنياء، ومنذ أربع سنوات لم أدخل مدرسة مختلطة. لذلك كنتُ افتقدُ الثقة بالنفس، بائساً، شاعراً بأنني خارج طبقة أترابي. رجوتُ أبي أن يوافقَ على خروجي من تلك الكلية أو أن آخذ إجازةَ سنة. أردتُ أن أذهبَ إلى بوسطن لأخبُرَ الحياةَ والنساء هناك. لكنه لم يكن ليُنصت. كان يتساءل: “كيف لي أنْ أزعمَ أنني أُعدُّ أولاد غيري من الآباء للجامعة إذا كان ولدي أنا لا يتقبلها؟”
أدركتُ فيما بعد أنّ الحياةَ سلسلةٌ من المصادفات. وكلُّ شيءٍ فيها يتلخَِّصُ بطريقةِ تفاعلنا معها – وطريقةِ ممارسة ما يُسميه بعضُهم “الإرادة الحرة”. واختياراتُنا ضمنَ تعرُّجاتِ القدر تُقرِّرُ من نحن. وقد حدثت في مِدِلْبَري مصادفتان أساسيتان طبعتا شكل حياتي. إحداهما تتعلّقُ بشابٍّ إيرانيٍّ كان ابنَ ضابطٍ عسكريٍّ كبير مستشارٍ للشاه؛ والأخرى تتعلَّقُ بفتاةٍ جميلةٍ اسمُها آن، كاسم حبيبتي أيام الطفولة.
الأول، وسأسميه فرهَد، كان يلعبُ كرةَ القدم في روما لعباً احترافيا. وكان ذا جسم رياضيٍّ، وشعرٍ أسودَ مُجعّدٍ، وعينين خضرواين صافيتين، وخلفيةٍ وجاذبيةٍ لا تملك النساءُ مقاومةً أمامهما. كان على العكس مني في كثير من الأمور، فأجهدتُ نفسي للظفر بصداقته. وقد علّمني كثيرا من الأشياء التي أفادتني في قادم أيامي. كذلك التقيتُ بآن. وبالرغم من أنها كانت على علاقةٍ جادّةٍ بشابٍّ في كلية أخرى، فقد أخذتني تحت جناحها. وقد كانت علاقتنا العذرية أول حبٍّ صادقٍ خبرته في حياتي.
شجعني فرهد على الشُّرب والذهاب إلى الحفلات وتجاهل والديّ. فاخترتُ مُتعمِّداً أنْ أتوقف عن الدراسة، وقرّرتُ أنْ أكسر ساقي المدرسية لأنتقم من أبي. فكان أنْ هبطتْ علاماتي، وخسرتُ منحتي الدراسية. وفي منتصف سنتي الثانية قرَّرتُ أن أترك الدراسة، فهددني أبي بأن يتبرّأ مني؛ لكنّ فرهد حثني على المضيِّ قُدُما. وهكذا انطلقتُ إلى مكتب العميد وتركتُ الدراسة. لقد كانت لحظةً محوريةً في حياتي.
في حانةٍ محليةٍ احتفلتُ أنا وفرهد بآخر ليلةٍ لي في المدينة. وهناك اتهمني مزارعٌ مخمورٌ ضخمُ الجثة بمغازلةِ زوجته، فحملني وقذفني على الجدار. عندها اعترضه فرهد واستلّ سكيناً شرط بها خدَّ المزارع. ثم جرّني من الغرفة ودفعني عبر النافذة، فقفزنا وعدنا بمحاذاة النهر إلى مسكن الطلاب.
في صباح اليوم التالي، حين استجوبتني شرطةُ الحرم الجامعي، كذبتًُ ورفضتُ الاعتراف بعلمي بالحادث. بالرغم من ذلك، طُرد فرهد، فذهبنا كلانا إلى بوسطن، حيث اشتركنا في شقة واحدة. وجدتُ هناك وظيفةَ مساعدٍ شخصيٍّ لرئيس تحرير جريدة صنداي أدفيرتايزر.
في تلك السنة، 1965، تمّ تجنيدُ العديدِ من أصدقائي في الجريدة، فدخلتُ كلية إدارة الأعمال في جامعة بوسطن لكي أتجنب المصير ذاته. في هذا الوقت، انفصلتْ آن عن صديقها القديم، وكثيرا ما كانت تأتي من مِدِلْبَري لتزورني، فكنت أرحِّبُ باهتمامها. ثم تخرّجتْ هي عام 1967، بينما بقي لي عام واحد لأتخرَّج من جامعة بوسطن. وقد رفضتْ بعنادٍ أن تعيشَ معي قبل أنْ نتزوّج. لكني استمتعتُ بصحبتها بالرغم من أنني كنتُ أمازحُها بتعرُّضي للابتزاز. والحقيقةُ أنني شعرتُ بالاستياء لما وجدتُ فيه استمراراً لمقاييس والديَّ الأخلاقية المحافظة، والتي عفا عليها الدهر. لكننا أخيرا تزوّجنا.
كان والدُ آن مُهندساً ألمعيّاً، وكان العقلَ المخطِّطَ لنظام ملاحيٍّ لنوع مهمٍّ من الصواريخ؛ فكوفئ بمنصبٍ عالٍ في البحرية. وكان صديقُه الحميم رجلا تُخاطبُه آن بالعم فرانك (وهذا ليس اسمَه الحقيقي)، يشغل مديرا تنفيذيا في أعلى مراتب وكالة الأمن القومي، وهي المنظمةُ التجسسيةُ الكبرى والأقلُّ شهرةً في البلاد.
بعد زواجنا بقليل استدعاني الجيشُ للفحص الطبّي. وإذ نجحتُ في الفحص، واجهتُ إمكانيةَ التجنيدِ بعد تخرُّجي [للحرب] في فيتنام. وبالرغم من أنّ الحرب كانت دائما تستثيرُ في نفسي السحر، إلا أنّ فكرة القتال في جنوب شرق آسيا قد مزَّقتني عاطفيا. لقد شببتُ على سماع حكايات أسلافي المستوطنين – ومنهم طومَس بين وإيثَنْ أَلِنْ،* وكنتُ قد زرتُ جميع مواقع المعارك الفرنسية والهندية وحروب الثورة في نيوإنكلَند وفي أعالي ولاية نيويورك، وقرأتُ كلَّ الروايات التاريخية التي وقعت بين يديّ. بل إنني كنت تواقاً للتطوع في القوات الخاصة التي دخلت فيتنام لأول مرة. لكنَّ قلبي تحوَّلَ حين كشفتْ وسائلُ الإعلام عن الفظائع وعن تذبذب السياسة الأمريكية. وجدتُني أتساءلُ: تُرى مع أي جانب يمكنُ طومَس بين أن يكون؟ وكنتُ متأكِّداً من أنه سوف ينحاز لأعدائنا من الفيتكُنغ.
أنقذني العمّ فرانك. أخبرني أنَّ الحصولَ على وظيفةٍ في وكالة الأمن القوميِّ تمنحُ صاحبَها فرصةَ تأجيل تجنيده الإجباري؛ وقد رتّب لي سلسلة اجتماعات في وكالته، منها يومٌ مرهقٌ من المقابلات المرصودة على جهاز كشف الكذب. قيل لي إن هذه الفحوصات سوف تُقرِّرُ ما إذا كنتُ مؤهَّلاً للعمل والتدريب في تلك الوكالة. فإنْ كنتُ كذلك، فسوف تُعطي النتائجُ لمحةً عن نقاط قوتي وضعفي، وتُستخدمُ لتقرير سيرتي العملية. وبسبب موقفي من حرب فيتنام، كنتُ مُقتنعاً من أنني سوف أرسبُ.
اعترفتُ في أثناء الفحص بأنني، كأمريكي مخلص لوطني، أعارضُ حرب فيتنام. ولدهشتي، لم يهتمَّ من قابلوني بالأمر، وبدل ذلك ركَّزوا على نشأتي، وعلى نظرتي لوالديّ، وعلى شعوري المتولِّدِ من كوني نشأتُ “بيوريتانياً” فقيراً بين تلاميذَ أغنياءََ مشدودين لمبدأ المتعة. كذلك تحرَّوا عن شعوري بالإحباط لعدم وجود النساء والجنس والمال في حياتي، وعن عالم الخيال الذي تولَّد من ذلك. وقد استغربتُ اهتمامَهم بعلاقتي بفرهد وبقبولي أنْ أكذبَ على أمن الجامعة لحمايته.
افترضتُ في بادئ الأمر أن كلَّ ما بدا سلبياً من جانبي لا بد أن يُشكِّلَ عاملَ رفض لي من قبل وكالة الأمن القومي؛ لكن استمرارَ من قابلوني معي وشَى لي بغير ذلك. ولم أعلمْ إلا بعد ذلك بسنوات أنّ هذه السلبياتِ كانت إيجابياتٍ في نظر تلك الوكالة. كان تقييمُهم مهتماً بما واجهتُ من إحباطاتٍ في حياتي أكثر من مسألة الولاء لبلادي. فاستيائي من والديَّ، والهاجسُ النسائيُّ لديّ، وطموحي إلى حياة أفضلَ أعطاهم وسيلةَ اقتناصي؛ كنتُ ذا قابليةٍ للغواية. كذلك فإن تصميمي على التفوّق في المدرسة وفي الرياضة، وتمرُّدي أخيرا على والدِي، وقدرتي على معاشرة الأجانب، وقبولي الكذبَ على أمن الجامعة، كانت كلُّها المناقبَ التي يبحثون عنها. كذلك اكتشفتُ لاحقاً أنّ والدَ فرهد كان يعمل مع الاستخبارات الأمريكية في إيران؛ لذلك اعتُبِرَتْ صداقتي مع فرهد نقطة إيجابية مؤكَّدة.
بعد فحصي من قبل وكالة الأمن القومي بأسابيعَ قليلةٍ، استلمتُ عرضَ عمل للبدء في التدريب على فنِّ التجسُّس يبدأ بعد عدة أشهر حين أنالُ شهادتي من جامعة بوسطن. غير أني، قبل قبولي العرضَ بصورةٍ رسمية، اندفعتُ إلى الالتحاق بحلقةٍ دراسيةٍ في جامعة بوسطن تُنظَّمُ للتجنيد في فرقة السلام، حيث كانتْ النقطةُ الأساسيةُ المُغريةُ لديهم جعلَ المرء مؤهلا لتأجيل تجنيده العسكري، كما هو الحال لدى وكالة الأمن القومي.
كان قرارُ الالتحاق بتلك الحلقة الدراسية واحدةً من تلك الصدف التي تبدو غير مهمة في حينها ولكنها تُثبتُ أنها ذاتُ آثار مُُغيِِّرةٍ لمجرى الحياة. وَصَفَ القائمُ على التجنيد عدةَ أماكنَ في العالم كانت في حاجةٍ ماسّةٍ للمتطوِّعين. أحدُها كان في غابة الأمازون المطيرة حيث يعيشُ السكانُ الأصليون، حسب قوله، كما كان عليه حالُ السكان الأصليين في أمريكا الشمالية قبل وصول الأوربيين.
كنتُ دائماً أحلمُ بالعيش مثل الأبناكيين الذي كانوا يقطنون في نيوهامبْشَيَر حين استوطنها أسلافي. وإذ كنتُ أعلمُ أنّ لديَّ دما أبناكياً يجري في عروقي، أردتُ أن أتعرَّفَ على ثقافتهم في الغابة. لذلك تقدّمتُ إلى القائم على التجنيد بعد محاضرته وسألتُه عن إمكانية عملي في الأمازون، فأكد لي أنّ ثمة حاجةً كبيرةً جدا للمتطوِّعين في تلك البقعة وأن حظوظي ستكون وافرة. عندها هاتفتُ العم فرانك.
ولدهشتي، شجّعني العم فرانك على التفكير بفرقة السلام. وأسرَّ لي أنه بعد سقوط هانوي – وكانت يومئذٍ لمن في مركزه مسألةً مفروغاً منها – سوف يصبح الأمازون نقطة ساخنة.
قال: “إنها مفعمةٌ بالنفط، وسنحتاجُ هناك إلى عملاءَ جيدين – أناسٍ يُمكنُهم التفاهمُ مع السكان المحليين.” وأكَّد لي أنّ فرقةَ السلام مكانٌ ممتازٌ للتدريب، مُلِحّاً عليّ أن أُتقنَ اللغةَ الإسبانيةَ واللهجاتِ المحليةَ هناك. ثم قال ضاحكا، “قد ينتهي بك الأمرُ أن تعمل في شركةٍ خاصّةٍ بدل الحكومة.”
لم أفهمْ يومَها ما كان يقصدُ من قوله. كنتُ أترقّى من جاسوس إلى قاتل اقتصادي، بالرغم من أنني لم أسمع قطُّ بذلك التعبير ولم تتسنَّ لي معرفتُه لسنوات لاحقة. لم تكن لديّ فكرةٌ أن ثمّةَ مئاتِ الرجال والنساء منتشرين حول العالم، يعملون لدى شركاتٍ استشارية وغيرها من الشركات الخاصّة، لا يقبضون فلساً واحداً من أية مؤسسة حكومية، ولكنهم يخدمون مصالح الإمبراطورية. ولم يخطرْ ببالي أيضاً أنّ نوعا جديداً، بألقابٍ لطيفة، سيبلغ الآلاف عدداً في نهاية الألفية، وأنني سوف أقوم بدور مهمٍّ في تشكيل هذا الجيش المتنامي.
قدَّمنا، آنْ وأنا، طلباً للالتحاق بفرقة السلام وطلبنا أن تكون خدمتنا في الأمازون. وحين وصلنا إشعارُ القبول، كانت خيبةُ الأمل القصوى أولَ ردة فعل لديّ. فقد ذكرتْ الرسالةُ أننا سوف نُرسَلُ إلى الإكوادور. فقلتُ لنفسي، كنتُ طلبتُ الذهابَ إلى الأمازون، لا إلى أفريقيا.
استطلعتُ من الأطلس موقعَ الإكوادور، فشعرتُ بالاستياء أنني لم أستطع أنْ أجدَها في أي مكان في القارة الأفريقية. لكنني تبيّنتُ من الفهرس أنها تقع حقيقةً في أمريكا اللاتينية، وعلى الخريطة رأيتُ أنّ النظامَ النهريَّ المتدفِّقَ من الأنهار الجليدية في الأنديز يُُشكِّلُ الروافدَ الأولى للأمازون العظيم. ومن قراءاتي اللاحقة عرفتُ أنّ أدغالَ الإكوادور كانت بعضَ أكثر غابات العالم تنوُّعا وجبروتا، وأن سكانها لا يزالون يعيشون كما كانوا قبل آلاف السنين. لذلك قبلنا عرضَ العمل.
أنهينا، آنْ وأنا، تدريبنا في فرقة السلام في جنوب كاليفورنيا، ومضينا إلى الإكوادور في أيلول 1968. أقمنا في الأمازون مع الشوار الذين كان طرازُ حياتهم يُشبهُ حياةَ سكان أمريكا الشمالية الأصليين قبل الاستعمار؛ كذلك عملنا في الأنديز مع المتحدِّرين من الأنكاس. لقد كان ذلك مكانا من العالم لم يخطر ببالي قطُّ أنه لا يزال موجودا. فحتى ذلك الزمن، لم ألتق من الأمريكيين اللاتينيين إلا بالتلاميذ الأغنياء في المدرسة حيث كان أبي يُعلِّم. شعرتُ بالتعاطفِ مع هؤلاء الناس المحليين الذين كانوا يعيشون على الصيد والزراعة، وأحسستُ كذلك بنوعٍ غريبٍ من القرابة معهم، فقد ذكّروني بأهل البلدة الذين تركتهم خلفي.
ذاتَ يوم، حطت في مهبِطِ الطائراتِ طائرةٌ تحملُ رجلا يرتدي بذلة رجال الأعمال اسمه آينر غريف.* كان مساعد رئيس شركة تشاس ت. مين،** وهي شركةُ استشاراتٍ دوليةٌ كانت تلتزم عدم الظهور، وكانت مسؤولةً عن إجراء دراساتٍ يتقرَّرُ بموجبها ما إذا كان يُمكنُ البنكَ الدوليَّ أن يقدِّمَ قرضاً للإكوادور وللدول المجاورة لها بمليارات الدولارات لبناء سد كهرومائي وإقامة مشاريعَ بنيةٍ تحتيةٍ أخرى. وإلى ذلك، كان آينر ضابط احتياط في الجيش الأمريكيّ برتبة عقيد.
أخذ آينر يتكلّمُ معي حول منافع العمل مع شركةٍ مثل مين. وحين ذكرتُ له أنني كنتُ قُبِلتُ لدى وكالةِ الأمنِ القوميِّ قبل انضمامي لفرقة السلام، وأنني أُفكِّرُ في العودة لهم، أخبرني أنه أحيانا ما كان يعملُ ضابطَ اتصالٍ مع تلك الوكالة. وقد نظر لي بطريقة جعلتني أظنُّ أنّ جزءاً من مهمته كان تقييمَ إمكانياتي. والآن أعتقد أنه كان يُكملُ ما عندهم من معلوماتٍ عني، خاصّةً في تقدير قدراتي على العيش في بيئاتٍ لا يُطيقُها معظمُ الأمريكيين الشماليين.
أمضينا يومين معا في الإكوادور، وبعد ذلك أصبحنا نتراسل بالبريد. وقد طلب مني أنْ أرسلَ له تقاريرَ تُقيِّمُ إمكانيات الإكوادور الاقتصادية. وإذ كانت لديّ آلةٌ كاتبةٌ محمولةٌ، وكنتُ أحبُّ الكتابة، كنتُ سعيداً في الاستجابة لطلبه. وخلال سنةٍ أرسلتُ لآينر ما لا يقلُّ عن خمسَ عشْرةَ رسالةً، أودعتُ فيها تقديري لمستقبل الإكوادور الاقتصادي والسياسي. كذلك شرحتُ الإحباط المتنامي بين المجتمعات المحلية في كفاحها ضد شركات النفط، ووكالات التطوير الدولية، والمحاولات الأخرى لجرِّهم إلى العالم الحديث.
حين انتهت جولتي مع فرقة السلام، دعاني آينر إلى مقابلةٍ لوظيفةٍ في شركة مين في مقرِّها الرئيسي في بوسطن. وفي اجتماعنا الخاصّ أكّد لي أنّ عمل “مين” الرئيسي هو الهندسة. لكنّ أكبرَ عملائها، وهو البنك الدولي، بدأ حديثا يُصرُّ على وجود اقتصاديين بين موظفيهم لوضع التنبؤات الاقتصادية المهمة التي يُعتمَدُ عليها في تقرير جدوى المشاريع الهندسية وحجمها. وقد أسرَّ لي أنه كان استخدم ثلاثة اقتصاديين ذوي مؤهلاتٍ عالية وشهادات ممتازة – منهم اثنان يحملان الماجستير وثالثٌ يحمل الدكتوراه. لكنّ ثلاثتهم رسبوا بطريقة مخزية.
قال آينر، “ما من أحدٍ منهم كان قادراً على التعامل مع فكرة إنتاج تنبؤاتٍ اقتصاديةٍ في بلاد لا توجد فيها إحصاءاتٌ يُمكن الاعتمادُ عليها.” وأضاف قائلا إنهم، إلى ذلك، وجدوا من غير الممكن لهم أن يُوفُوا ببنود عقودهم التي اقتضت منهم السفرَ إلى أماكنََ بعيدةٍ في بلاد كالإكوادور، وإندونيسيا، وإيران، ومصر، لكي يقابلوا القادة المحليين ويُقدِّموا تقديراتٍ شخصيةً حول إمكانات التنمية الاقتصادية في تلك البقاع. وقد أُصيب أحدُهم بانهيار عصبيٍّ في قريةٍ معزولةٍ في بنما؛ مما جعلَ الشرطةَ البنميةَ تحملُه إلى المطار وتضعُه في طائرةٍ أعادته إلى الولايات المتحدة.
“تُشيرُ الرسائلُ التي أرسلتَها لي أنه لا مانعَ لديك من أنْ تحشرَ أنفَك، حتى لو لم تتوافر المعطيات المؤكَّدة. وبالنظر إلى الأحوال المعيشية التي واجهتَها في الإكوادور، فإنني واثق من أنّ باستطاعتك العيشَ في أي مكان.” كذلك قال لي إنه أنهى خدماتِ أحد هؤلاء الاقتصاديين ومستعدٌّ لفعل الشيء ذاته مع الآخرَيْن إنْ أنا قبلتُ الوظيفة.
وهكذا كان أنْ عُرِضَ عليَّ في كانون الثاني 1971 منصبُ اقتصاديٍّ في شركة مين. يومها كنتُ بلغتُ السادسة والعشرين من عمري، وهو السن السحريُّ الذي يجعلُ مجلس الخدمة العسكرية لا يريدني. استشرتُ أسرةَ آن، فشجعتني على قبول الوظيفة؛ وافترضتُ أن رأيها هذا انعكاسٌ لرأي العمّ فرانك. وقد تذكّرتُ قوله بإمكانية أنْ ينتهي بي الأمرُ إلى العمل في شركةٍ خاصّة. بالرغم من أنّ شيئاً من هذا لم يُذكرْ بصراحة، إلا أنني لم أشكَّ في أن توظيفي في شركة مين كان نتيجةً لترتيبات العمّ فرانك قبل ثلاث سنوات، بالإضافة إلى خبرتي في الإكوادور واستعدادي للكتابة عن الوضع الاقتصاديّ والسياسيّ لتلك البلاد.
لأسابيع كان رأسي يدور، وقد كبرتْ عندي الأنا. ذلك أنني لم أنلْ أكثرَ من درجةِ بكالوريوس من جامعة بوسطن لا تُبرِّرُ تبوُّئي منصبَ اقتصاديٍّ لدى مثل هذه الشركة الاستشارية الكبيرة. كنتُ أعلمُ أني سأكونُ موضعَ حسدِ الكثرةِ من زملائي في جامعة بوسطن ممن لم يُقبََلوا للتجنيد العسكريِّ، ومضَوا للحصول على المَجستير في إدارة الأعمال أو غيرها من الشهادات العليا. تصوَّرتُ نفسي عميلا سريّاً مندفعاً، يذهبُ إلى البلاد الغريبة، ويستلقي في برك السباحة في الفنادق، تُحيط به الحسناوات شبهَ عاريات، وكأس الخمر لا ينزل من يده.
وبالرغم من أنّ هذا ليس سوى محضِ خيال، إلا أنه لم يخلُ من حقيقة. لقد استخدمني آينر كاقتصاديٍّ، لكنني علمتُ بسرعةٍ أنّ وظيفتي الحقيقيةَ كانت أبعدَ من ذلك بكثير، وأنها أقربُ إلى عمل جيمس بوند مما كان يُمكنُ أنْ يخطرَ ببالي.