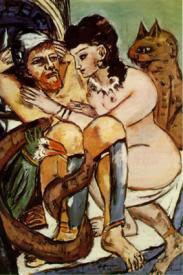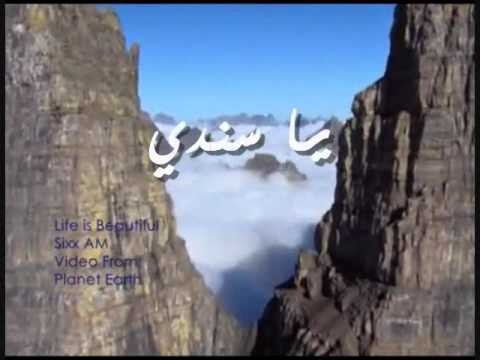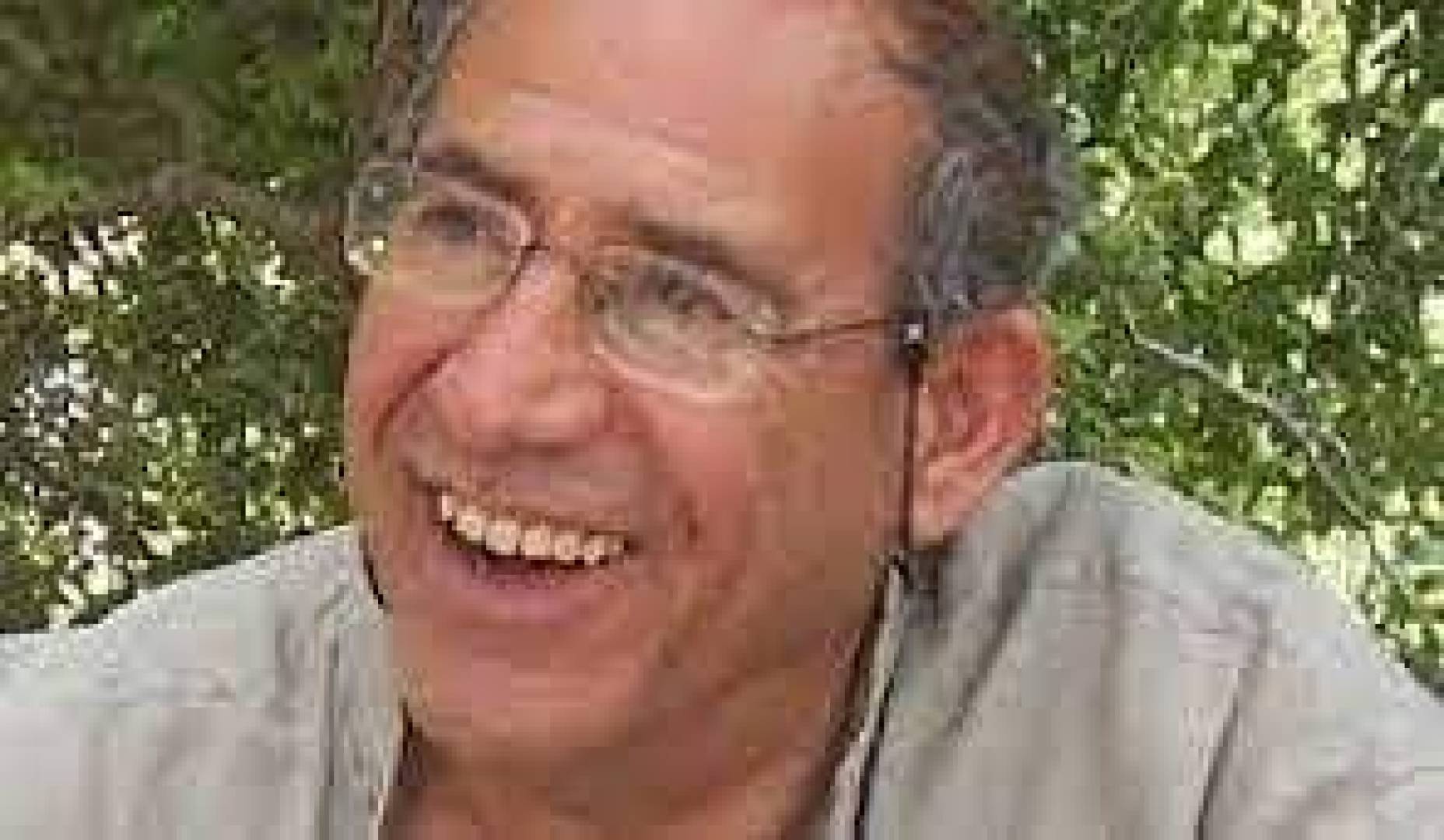جورج حدادين
10/5/2025
منتدى الفكر الاشتراكي
هذه ليست مداخلة ولا محاضرة، بل محاولة طرح مشروع بخطوط عامة يحتاج الى حوار معمق ومركز، في القادم من الأيام.
الخروج من الأزمة، موضوع يشغل بال كل من له علاقة بالهم العام:
نخب، أكاديمين، سياسين، اقتصادين و مثقفين
في البدء لا بد من تشخيص طبيعة الأزمة القائمة، بالفعل وفي الواقع، لكي نتمكن من البحث عن حلول حقيقية موضوعية وعلمية، بناء على معطيات وحقائق.
جوهر الأزمة يكّمن في قانون التبعية والرضوخ للإملاءات الخارجية
والتداعيات:
• أزمة شاملة تعمّ كافة مناحي الحياة: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
• أزمة بنية دولة وبنية مجتمع، وبني قوى اجتماعية وقوى سياسية وشعبية.
• أزمة تناقضات تشكيلة اقتصادية - اجتماعية بدائية مشوهة.
• أزمة بنيوية تشمل كافة القطاعات والأطر: النقابية العمالية والمهنية والاتحادات الشعبية، والمؤسسات الثقافية والتعليمية والإعلامية والسلوك العام.
الأزمة، في الحقيقة والواقع، ليست أزمة إدارية ( عجز إداري ) ولا مهنية ( غياب الكفاءات ) ولا أخلاقية ( الفساد والإفساد ) ، كما يدعي البعض، بوعي أو بلا وعي، طرح يهدف الى حرف الأنظار عن علّة وسبب الأزمة الحقيقي، انما هي أزمة بنية ونهج.
أزمة دولة وظيفية ريعية مستهلكة تابعة، تعتمد على المساعدات الخارجية والقروض الميسرة والضرائب المباشرة وغير المباشرة لإدارة شؤونها، لتفقد بذلك قرارها الوطني المستقل، وتخضع لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، أدوات الطغمة المالية العالمية، فلم ولن يسمح لهذا البلد بناء اقتصاد وطني منتج، ولا دمج المجاميع ليتشكل مجتمع حديث، بمفهوم علم الاجتماع،
ويتم ذلك من خلال منع حصول تراكم رأسمالي وطني ، ومنع حصول تراكم معرفي بشقيه التقني والإداري.
وبما أن الدولة بنية وظيفية، فإن البنية تنمو وتتبدل بنمو الوظيفة وتبدلها، ومعها تتبدل وظيفة المؤسسات القائمة بداخلها، أي أن التبدل لا يحصل جراء تغيير الدساتير والقوانين والأنظمة والتعليمات، بل بسبب شروط خارجية، ولذلك يعتبر مشروع الاصلاح، في ظل التبعية، ضرب من الوهم والخيال،
تبني مشروع قائم على إصلاح القوانين والأنظمة والتعلميات، أي إصلاح البنى الفوقية، دون أن يسبقه تغيير للبنى التحتية، عبث ووهم.
الكثير من علماء الاجتماع لا يعتبرالدولة الماقبل رأسمالية، دولة بل سلطة ما قبل الدولة، وذلك لكونها تجمع مجاميع بدائية، عشائرية ( بلا عشائر ) وقبائلية ( بلا قبائل ) وإثنية ( بلا تمركز ) ومناطقية وإقليمية…الخ داخل حدود جغرافية، لم تتمكن،لا بل لم يسمح لها، دمج هذه المجاميع لتشكل المجتمع المندمج الموحد، الذي هو أحد أهم شروط تشكّل الدولة، بالإضافة الى غياب استراتيجية بناء اقتصاد وطني منتج مستقل.
" تعرف الدولة التابعة، بأنها الدولة التي تضع نفسها باتفاق مبرم، علني أو سري أو شفوي، طوعاً أو رغماً عنها في حماية قوة أجنبية، تتولى مسؤولية حمايتها"
فتحدّد دولة الحماية طريق تطور وشكل حكم الدولة المحمية التابعة، وتخضع المجتمع والثروات الطبيعية والمقدرات الوطنية، والسياسة الخارجية والثقافية لسلطة قوة الحماية وخدمة مصالح شركاتها العملاقة.
وبالإعتماد على وظيفة ودور الدولة التابعة تحدّد الدولة الحامية الدرجة المسموح بها لتطور الدولة التابعة، رغم ذلك هناك مبدأ مشترك يجمعها وهو أن هذه الرابطة تفترض بصفة عامة حرمان أو تحديد ممارسة الدولة التابعة لسيادتها الوطنية المستقلة، في الداخل والخارج، مع احتفاظها بحرية تصريف كل أو بعض شؤنها الداخلية.
ويلاحظ أن دول التبعية تتمتع بأحد الميزات التالية:
1. امتلاك ثروات طبيعية هائلة، مثل ، السعودية وباقي دول الخليج العربي، وبعض دول افريقيا وأمريكا اللاتينيةً.
2. موقع جيوسياسي، على تقاطع خطوط التجارة العالمية البرية أو البحرية، مثل اليمن ودول القرن الأفريقي، جمهورية بنما، تركيا، ودول طريق الحرير. ولهذا السبب قد نفهم لماذا الحروب المتتالية على اليمن.
3. عقدة جيوسياسية، موقع جغرافي يؤمن الهيمنة العسكرية للمركز الرأسمالي العالمي، مثل، دول البلطيق ، دول جنوب شرق أسيا، والأردن والعراق.
يعتمد السماح لتطور الدولة التابعة من عدمه، على طبيعة الوظيفية التي تؤديها لصالح المركز الرأسمالي:
دولة تابعة، يسمح لها، وتساهم الدولة المهيمنة في تطورها، لكي تلعب دور الخنجر في خاصرة الدولة المعادية أو المنافسة لها، مثلاً النمور الأسيوية، تقع جغرافياً بالجوار من دولة قوية ( الصين) معادية أو منافسة لدولة الهيمنة ( الولايات المتحدة)،
واخرى يتم تطوير قطاع الخدمات لتسهيل استغلال ثرواتها الطبيعية، السعودية ودول الخليج وكثير من الدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية.
• نموذج تركيا، خاص، عمل المركز الرأسمالي العالمي، بداية العقد الأول من هذا القرن، على استيلاد برجوازية أناضولية اسلاموية بديلاً عن البرجوازية الإستنبولية العلمانية، وساهم في إحداث نهضة اقتصادية، لتمثل نموذج الأسلام الأمريكي المعتدل، لتعميمه في المنطقة، لسببين:
1. حجز بناء دولة الأمة العربية،
2. تقديم نموذج اسلامي مناقض للمشروع الإيراني.
4: نموذج " الكيان الصهيوني" نموذج آخر لدولة تابعة مكّنها المركز من بناء قوة عسكرية واقتصادية، ويحرص دوماً على مدّها بأسباب القوة الاقتصادية والعسكرية والمعنوية ، وحمايتها في أروقة المؤسسات الدولية، ويضمن تفوقها على مجمل الدول العربية مجتمعة، كونها تمثل كلب حراسة مصالح دولة الهيمنة الأمريكية داخل المنطقة.
•
الأردن بالمقابل دولة تابعة، صممت دولة لخدمة مشاريع اسكان مهجرين قصراً، بناء على رؤية مستقبلية للمنطقة من قبل المركز، بما يخدم مصالحه، قائم على:
تفكيك الدول وتفتيت المجتمعات،
ما بعد مؤتمر القاهرة ، أذار عام 1921 أخرج الأردن من وعد بلفور، وفي الوقت ذاته عملت قوى الاستعمار المباشر ( بريطانيا ) ومن ثم الهيمنة ( الولايات المتحدة)، على ابقائه في حال عوز وفقر دائم، منذ التأسيس، وتم حجز تطوره الاقتصادي والاجتماعي، بسبب أولوية ومركزية الدولة الصهيونية بالنسبة للولايات المتحدة، وستبقى هذه الحالة قائمة، ما لم تتمكن الشرائح الوطنية الكادحة والمنتجة من فرض التغيير.
الجميع يبحث عن حلول حقيقية للخروج من الأزمة،
بناء على هذه الخطوط العامة لتشخيص الأزمة .
تبلور مقاربتين للخروج من الأزمة:
1: مقاربة الاصلاح ، ( مشروع الحداثة )
مقاربة تتبنى سياسة تغيير البنى الفوقية، القانونية، تعتمد سياسة رفع مطالب،
جربت على مدى عمر هذه الدولة، ومنذ المؤتمر الوطني الأول ولحد اليوم، فشلت ولم تنجز، لم يتحقق من المطالب شيء ، وصولاً الى الميثاق الوطني، حيث انخرطت كافة الأحزاب السياسية بمشروع إدارة الأزمة، أملاً أن يكون لها حصة ونصيب، ورغم رضوخها لكافة شروط السلطة السياسية، لم تجني الأ الضمور والإضمحلال.
2: مقاربة تغيير النهج، ( مشروع نهضوي ) يستند الى تغيير البنى التحتية والفوقية، تغير بنية التشكيلة الاقتصادية – الاجتماعية والسياسية متمثلة في مشروع التحرر الوطني، ومهمات مرحلة التحرر الوطني:
كسر التبعية للمركز الرأسمالي
تحرير الإرادة السياسية
تحرير الثروات الطبيعية المحتجزة
صياغة خطط تنموية وطنية ومحلية، متمحورة حول الذات الوطنية.
بناء دولة الأمة.
إعادة بناء النقابات العمالية والمهنية وتطهيرها من القيادات المندسة والإنتهازية، وصياغة مشاريع تنهض بها، وتلتزم مصالح العمال، وتلتزم بالمساهمة في صياغة خطط وطنية تنموية خاصة وأنها بيوت خبرة.
إعادة بناء الاتحادات والمؤسسات الشعبية لتخدم منتسيبها.
التوافق على مشروع ثقافي نهضوي يجمع كافة الأطر الثقافية الشعبية
إعادة بناء العلاقة الجدلية بين كافة القوى الاجتماعية للنهوض بمشروع التحرر الوطني.
وبناء عليه فأن مقاربتان تنظيميتان تتنافستان على الساحة،
مقاربة التوافق على إطار،
مقابل مقاربة التوافق على مشروع
• مقاربة الاصلاح، التوافق على تجميع أفراد وجماعات، تجميع قوى وفعاليات مختلفة، ، ضمن إطار، بالرغم من عدم توفر شروط هذه المقاربة ، وبالممارسة لم تنجح طيلة أكثر من عشر عقود،
يتم تشكيل أطر تتفتت بعد وقت، تحت مسميات متعددة، مؤتمر وطني، جبهة وطنية عريضة، جبهة انقاذ، تحالف قوى...الخ ،
سبب الفشل المتكرر، يكمن في تناقض البنية والوظيفة، مشروع الاصلاح غير قابل للتطبيق بسبب قانون التبعية.
• مقاربة تغيير النهج، التوافق على مشروع، وبناء عليه يتم بلورة بنية تنظيمية، إطار، يتوافق مع المشروع ذاته،
يتم بناء حامل اجتماعي يتوافق مصلحياً مع هذا المشروع، ويتمثل في توافق ممثلي الشرائح الوطنية، الكادحة والمنتجة، والنخب المنتمية والمقهورين والمهمشين والمعذبين في الأرض،
الخلاصة:
• الدولة الوظيفية الريعية المستهلكة التابعة، هي سلطة، لم تتطور الى دولة، بمفهوم علم الاجتماع
بسبب عدم تشكل مجتمع مندمج ( لم تندمج مجاميع ما قبل الدولة الحديثة ) وعدم نشؤ اقتصاد وطني مستقل ( اقتصاد تابع استهلاكي)
• الحل يكمن في العودة الى تبني متلازمة التحرر الوطني ( تحرير الأرض وثرواتها الطبيعية ومقدراتها الوطنية والإرادة السياسية)
والتحرر الاجتماعي ( تحرير المجتمع من الاستغلال والظلم والاضطهاد، وعدالة توزيع الثروة المنتجة بجهد الكادين، وتعميم القيم الإنسانية النبيلة )
• المصالح هي من يحرك البشر، والمبادئ تبنى على أساس المصالح، تبني مصالح الشرائح الوطنية الكادحة والمنتجة، هو محرك التغيير.
• تحرير النقابات العمالية والمهنية والاتحادات الشعبية من سيطرة الأجهزة الأمنية وأذرعها من الإنتهازين والمتسلقين والتابعين.
• تغيير النهج يتنتج عن تراكم انجازات يومية، في مجرى النضال، يؤدي الى تغير نوعي، في سياق استراتيجية تحررية محددة.
• التوافق على مشروع يضم كافة ممثلي الشرائح الوطنية الكادحة والمنتجة وبناء عليه يبنى الإطار المتوائم مع المشروع، وحامل اجتماعي يضم ممثلي هذه الشرائح.