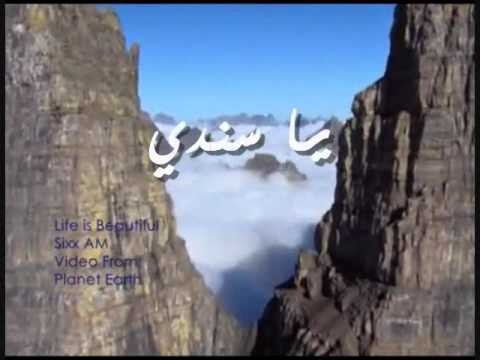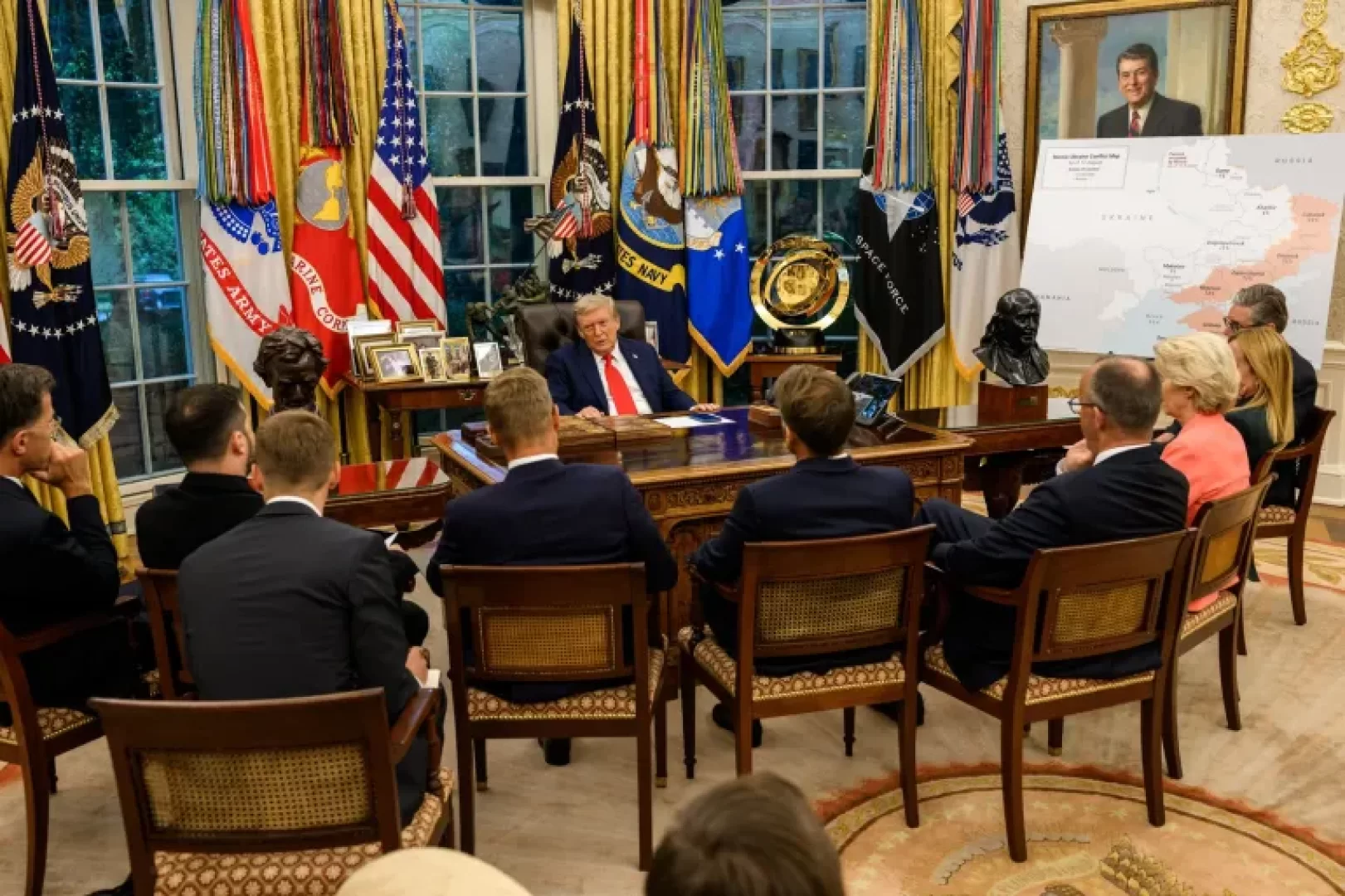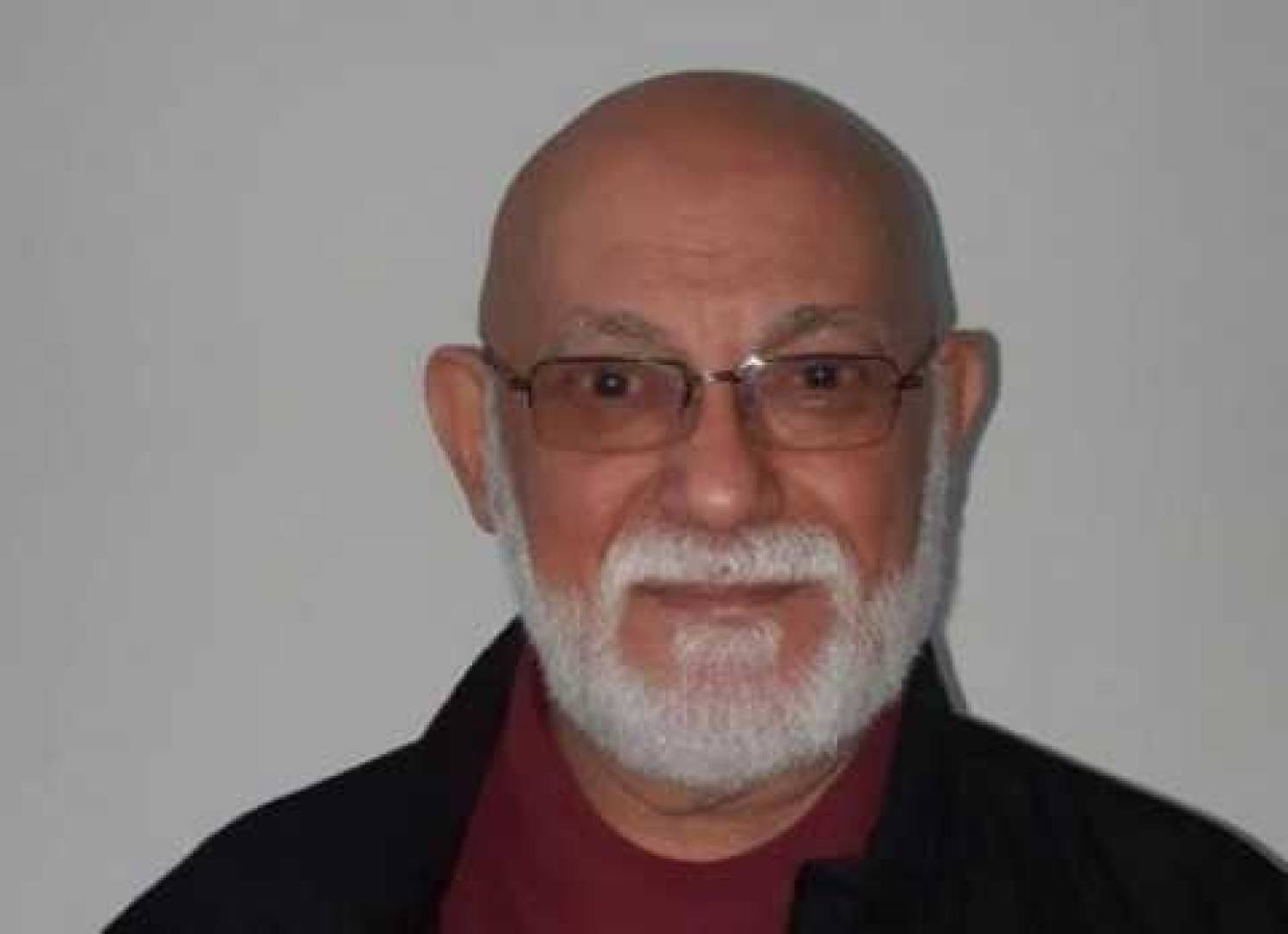دمشق - اسماعيل أحمد ديوب
يشهد النظام الدولي الراهن تحولات هيكلية عميقة وجذرية، تتجلى أبرز ملامحها في تآكل تدريجي ومستمر للهيمنة الأمريكية التي سادت منذ نهاية الحرب الباردة، هذا التآكل ليس نتاج عامل واحد، بل هو محصلة لتفاعل معقد بين عوامل داخلية وخارجية.
فعلى الصعيد الداخلي: تواجه الولايات المتحدة تحديات اقتصادية مزمنة، تزايداً في الاستقطاب السياسي، وتساؤلات متنامية حول جدوى الانخراط العسـ.ـكري المكلف في مناطق بعيدة.
أما على الصعيد الخارجي: فإن المشهد يتسم بتصاعد قوى دولية منافسة لم تعد تقبل بالهيمنة الأمريكية كأمر مسلم به. هذه القوى تتجسد في صيغ متعددة، بدءاً من التكتلات الاقتصادية والسياسية الناشئة مثل مجموعة البريكس، التي تسعى لإنشاء بدائل للمؤسسات المالية الغربية، ومنظمة شنغهاي للتعاون التي تعزز التعاون الأمني والسياسي بين أعضائها، وصولاً إلى دول فردية بارزة كروسيا والصين، حيث تشكل روسيا تحدياً مباشراً للنظام الأمني الأوروبي الذي تقوده واشنطن، بينما تمثل الصين المنافس الاستراتيجي الأكبر على المدى الطويل، نظراً لقوتها الاقتصادية الهائلة وتوسع نفوذها العالمي عبر مبادرات مثل "الحزام والطريق".
إلى جانب القوى الكبرى، يبرز دور متزايد لقوى إقليمية، من بين أهم هذه القوى، تبرز إيران كقوة إقليمية ذات نفوذ واسع يمتد عبر عدة دول في الشرق الأوسط (رغم انحدار هذا النفوذ بشكل علني) إلا أنه يُنظر إلى هذا في واشنطن كعامل يهدد الاستقرار الإقليمي التقليدي ويثير قلق حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. مع ذلك، فإن التقييم الاستراتيجي الأمريكي يبدو أنه قد تحول نحو التعامل مع إيران كقوة قائمة وفاعلة لا يمكن تجاهلها، بل يجب التعامل معها ببراغماتية، وهذا التعامل لا يعني بالضرورة القبول بنفوذها الحالي، بل قد يهدف إلى كسر نمط هذا النفوذ عبر إيجاد طرق لدمج إيران في ترتيبات إقليمية جديدة أو مشاريع اقتصادية كبرى قد تغير من ديناميكيات علاقاتها الإقليمية وتحد من اعتمادها على أدوات القوة الناعمة والصلبة التقليدية التي تستخدمها لمد نفوذها، هذا التوجه يمثل خروجاً عن سياسات العزل أو الاحتواء الصارم التي لم تحقق أهدافها بشكل كامل في الماضي.
في سياق هذا المشهد الجيوسياسي المعقد والمتغير، لوحظ تحول لافت في التوجه الاستراتيجي للولايات المتحدة، تجلى بشكل واضح خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث تَمثل هذا التحول في تبني مقاربة "أمريكا أولاً" التي سعت لتقليل الأعباء الاستراتيجية والمالية على الولايات المتحدة، فكان أحد الركائز الأساسية لهذه المقاربة هو تقليص الإنفاق العسكري والتدخل المباشر في النزاعات التي استنزفت الموارد الأمريكية على مدى عقود دون تحقيق مكاسب استراتيجية واضحة تتناسب مع التكلفة البشرية والاقتصادية. و بناءً على هذا التقييم، سعت الإدارة الأمريكية إلى إيجاد تسويات للنزاعات في المناطق الأكثر تعقيداً، ليس بالضرورة حباً في السلام، بل بهدف تحرير الموارد والطاقة الاستراتيجية للتركيز على المنافسة الكبرى مع الصين، التي تُعد التحدي الوجودي الأهم لموقع الولايات المتحدة كقوة عالمية مهيمنة. تضمنت هذه المقاربة الجديدة محاولة لإعادة تعريف العلاقات مع قوى دولية أخرى. فبدلاً من الانخراط في مواجهة شاملة مع روسيا، سعت واشنطن إلى تعزيز التنسيق معها في بعض الملفات، مثل محاولة إيجاد حلول للأزمة الأوكرانية (مقابل مكاسب اقتصادية تحصلها امريكا من اوكرانيا) أو قضايا الاستقرار الاستراتيجي، مع استراتيجية محتملة لتقليل التقارب المتزايد بين روسيا والصين، والذي يُعد أحد أخطر التطورات بالنسبة للمصالح الأمريكية، كما شملت هذه المقاربة السعي لكسب إيران، ليس كحليف تقليدي، بل كطرف يمكن التعامل معه ببراغماتية نظراً لموقعها وتأثيرها الإقليمي، بهدف محتمل لإبعادها عن المدار الصيني المتنامي في المنطقة، فيبدو أن الهدف الأوسع من هذه التحركات هو بناء نوع من التوازنات المعقدة، قد تشمل التعاون مع قوى مثل إيران وروسيا، بالاشتراك مع حلفاء تقليديين مثل دول الخليج، لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في مناطق حيوية، بدلاً من الانخراط في صراعات جانبية قد تضعف الموقف الأمريكي وتساهم في تسريع وتيرة بروز قوى دولية جديدة على حسابه. يُضاف إلى الأهداف الاستراتيجية والأمنية، أن حلحلة هذه النزاعات وإعادة تشكيل التحالفات والديناميكيات الإقليمية يفتح آفاقاً اقتصادية هائلة للولايات المتحدة. فمناطق الصراع غالباً ما تكون مناطق متعطشة لإعادة الإعمار والاستثمار في البنية التحتية والطاقة والقطاعات الاقتصادية الأخرى من خلال المساهمة في تحقيق الاستقرار، يمكن للشركات الأمريكية أن تحصل على فرص استثمارية مربحة في هذه المناطق، مما يعزز المكاسب الاقتصادية للولايات المتحدة في المدى الطويل ويساهم في تنشيط الاقتصاد الوطن، إن التحول من الإنفاق العسكري المباشر إلى الاستثمار في مناطق مستقرة يمثل تحولاً استراتيجياً يمكن أن يعود بفوائد اقتصادية ملموسة. في هذا الإطار المعقد من التحولات وإعادة التموضع الاستراتيجي، تبرز سوريا كعقدة جيوسياسية محورية تتداخل عندها مصالح القوى الكبرى والإقليمية بشكل حاد. تكمن أهميتها الجيواقتصادية في موقعها الجغرافي الحيوي كجسر بري يربط بين شرق البحر الأبيض المتوسط والعراق والأردن وتركيا ولبنان، هذا الموقع يجعلها نقطة ارتكاز حيوية لمشاريع نقل الطاقة المستقبلية، حيث يمكن أن يؤثر النفوذ الروسي أو الإيراني أو غيرهما على إمكانية مرور خطوط أنابيب الطاقة من دول الخليج أو حتى الهند عبر الأراضي السورية إلى أوروبا، مما قد ينافس إمدادات الطاقة الروسية التقليدية. كما أن موقع سوريا يعتبر حيوياً لمشروع "الحزام والطريق" الصيني، حيث يمكن أن تكون جزءاً من ممرات النقل البرية والبحرية التي تسعى الصين لتطويرها لربط آسيا بأوروبا وأفريقيا، مما يزيد من أهميتها في سياق المنافسة الجيواقتصادية الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن السيطرة على سوريا أو التأثير فيها يؤثر بشكل مباشر على أمن دول الجوار، بما في ذلك حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة كإسرائيل والأردن وتركيا، ويؤثر على ديناميكيات الصراع مع قوى غير دولية. بناءً على التحليل المذكور، يبدو أن الاستراتيجية المتبعة من قبل واشنطن تمثل خياراً براغماتياً يُنظر إليه على أنه يحقق مكاسب استراتيجية واقتصادية أكبر للولايات المتحدة في ظل الظروف الدولية الراهنة مقارنة بالخسائر المحتملة للاستمرار في مقاربات تقليدية أثبتت محدوديتها، لتجد أن التعامل مع قوى مثل إيران كلاعبين فاعلين، والسعي لحلحلة النزاعات المعقدة، والتركيز على المنافسة الكبرى مع الصين، كلها عناصر تشير إلى إعادة تعريف للاستراتيجية الأمريكية تأخذ في الاعتبار تآكل الهيمنة وبروز عالم متعدد الأقطاب. ويبدو أن البدائل الأخرى، مثل الانخراط العسكري الأوسع أو العزل الشامل للقوى المنافسة، قد تحمل مخاطر كبيرة على موقع واشنطن الدولي وتزيد من استنزاف مواردها.