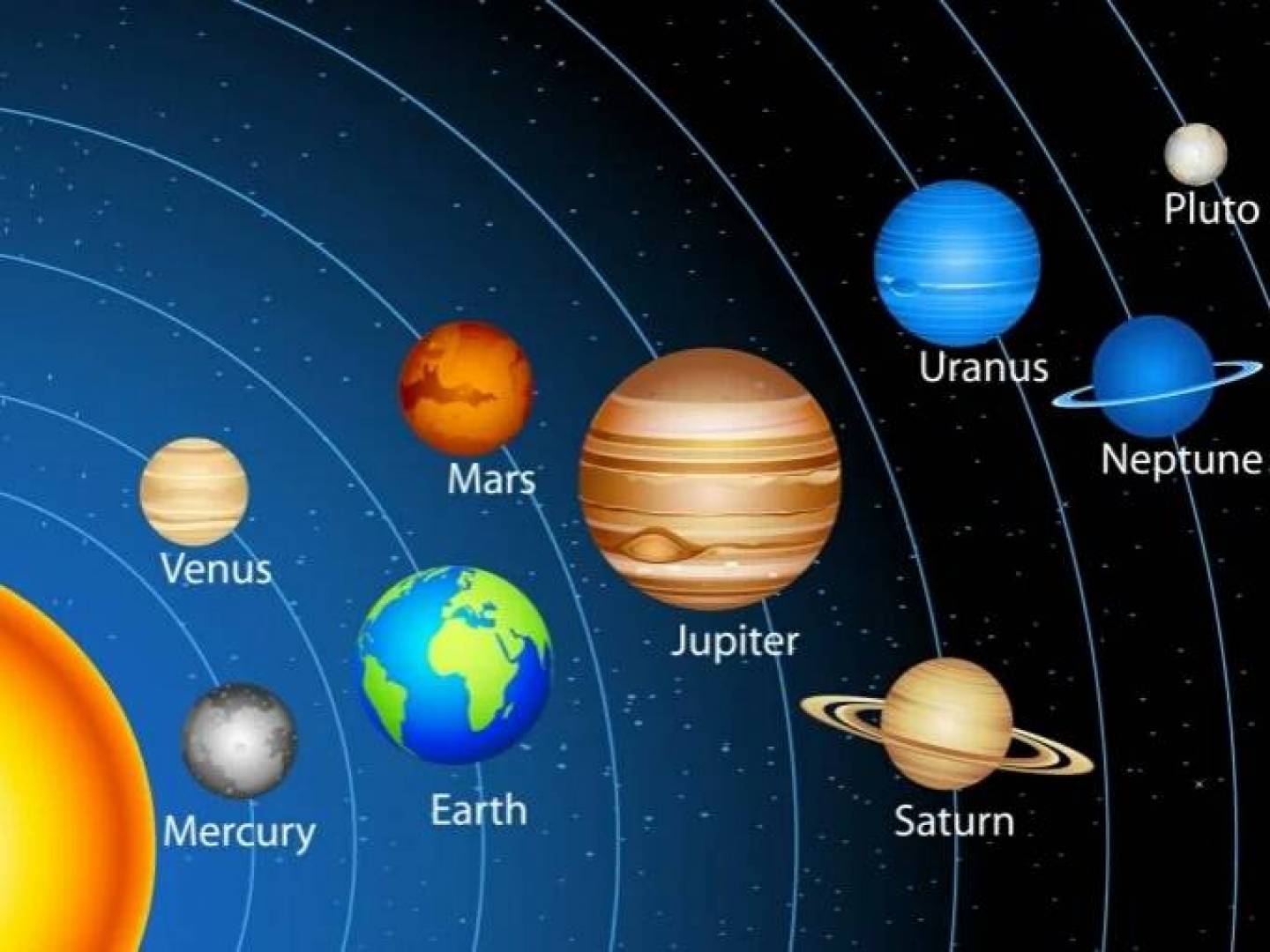كتبت إيمان شمس الدين:
الحقيقة بنية متينة، تحملها عقول لها قابليات عالية في مستوى وعيها وإدراكها، وفي ذات الوقت استفادت من تراكم التجربة البشرية عبر التاريخ، خاصة فيما يتعلق بموضوع الوظيفة والدور، والقرار، والزمان والمكان، فهي تعي وظيفتها، وتعي زمانها ومكانها، وتدرك الفارق الجوهري بين الأنا والذات والآخر.
فقد تكون الحقيقة تحتاج وجود هذه العقول لتستمر كواقع متحقق في الخارج، وقد تتطلب الحقيقة أن تضحي هذه العقول بوجودها في سبيل استمرارها.
فاستمرار الحقيقة ليس دوما متعلقا بخيار الحياة، بل قد يتعلق بخيار الموت، الذي تكون مقدمته النضال في الحياة والتضحية بها، متى ما تعلق استمرار وجود الحقيقة بذلك.
لذلك الوعي يتعلق بإدراك متى وكيف وأين، وبالخيار المناسب، وبفهم الفارق الجوهري بين الأنا؛ التي إذا تضخمت وباتت أصلا، ستضحي بالحقيقة في سبيل وجودها وبقاءها، بحجة أداء الدور وتحقيق الوعي، وبين الذات التي هي عبارة عن الأنا الفردية والأنا الجماعية، بحيث إذا تطلبت الحقيقة التضحية بالأنا الفردية لأجل الأنا الاجتماعية، التي من خلالها تعبر الحقيقة للأجيال القادمة، فإن الواعي والعاقل الحقيقي سيضحي بالأنا الفردية لحساب عبور الحقيقة من خلال دمه ووجوده.
الذات هي امتداد للفرد في جسد الجماعة، وهي تحقيق للجماعة في ذات الفرد، أما الأنا فهي الفردانية المنفصلة عن امتدادها في جسد الجماعة، والتي تنفصل في مصالحها الخاصة عن المصالح العامة التي تحقق منفعة الإنسان، فهناك فارق كبير بين كونية الإنسان، وفرديته.
خيار الوعي عادة ما تكون فيه تنازلات وتضحيات كبرى، أحيانا يقدمها الفرد لصالح الجماعة باتساع محيطها وجغرافيتها، وأحيانا تقدمها الجماعة، فالوعي هو إدراك عميق لحجم هذه التضحيات، وقابلية وفيرة لفهمها وتقبلها، هو خيار يحميك من نفسك، فالوعي يرسم معالم الأولويات، وأدواتها الرصينة في تنزيلها إلى أرض الواقع، وتمتلك به ريشة دقيقة في رسم هذه الأولويات في زمانها ومكانها المناسبين.
الوعي يصنع منك متبصرا بالواقع ومعطياته ومتنبأ بعواقب كل خياراته وقراراته، هذا التنبؤ الناتج عن وعي المحيط يجعل من صاحب الوعي، الحصن المنيع في حماية الناس من القرارات الخطيرة الفاسدة، لإدراكه لحجم تداعياتها وعواقبها عليهم وعلى مصالحهم الإنسانية، وعلى مصير كراماتهم من خلال مخرجات تحقيق العدالة، فلا يصنع الوعي من الشخص الواعي إلها ومرجعية لتقييم الحقيقة، ومرجعية للقيم يُقَيّم فعل محيطه وفقها، بل يفتح له آفاقا على كل فعل وقول حوله، فإن كان فعل حق وقول صدق، فقد يكسبه ذلك وعيا جديدا ويراكم فهمه للحقيقة، وإن كان فعل باطل وقول زور كذب، فإنه يدفعه لمراجعة ما لديه من سلوك ومعارف، لير هل ارتكب ذات الفعل، أو تفوه بذات القول، فهو بوابته لنقد ذاته ومراجعتها. وفي كلا الحالتين هو في ساحة علم وتعلم، وفي مسير متواصل نحو الكمال والتكامل، لأنه ليس كاملا، بل يسعى دوما للكمال.
المُصْلِح وقطب الرحى
قوة المصلحين الفكرية والفلسفية، وقدراتهم الإبداعية، تصبح بعد رحيلهم أو في وجودهم إما عبئ على من أتباعهم ومن يخلفهم، أو نوافذ تفتح أبواب معرفة.
وينقسم أتباع مدرسة هذا النوع من المصلحين بعد ذلك، إلى أقسام عدة أهمها:
١. الإفراط في تبني الأفكار، وبالتالي التشدد، من خلال أخذ أفكارها كنص مقدس كما هي، دون محاولة فهم سياقاتها التاريخية، أو وعي مدركاتها ودلالاتها، والعمل على إكمال مسيرتها ونقدها وتقييمها وتطويرها، مما يؤدي إلى نفور جموع الناس منها، بالتالي رفضها ونبذها.
٢. التفريط بهذه الأفكار ومكتسباتها، وحرفها عن دلالاتها، وتطبيقها بشكل ساذج أو سطحي، مما يؤدي إلى ضعفها وتلاشيها.
٣. الاعتدال في فهمها وتبنيها، ومحاولة تطويرها ونقدها وعدم الجمود عليها، ومراكمتها فكريا ومعرفيا، لتصبح جزء من مسار وسياق الاصلاح، بل جزء من بناء فضاء النباهة الاجتماعية داخليا.
وهذه الأفكار الاصلاحية في حينها، تشكل فضاء البناء الداخلي للأتباع معرفيا، وتعتمد هذه التشكيلات على قابلية فهم كل جزء في هذا البناء.
وكلما ابتعدت البنى الداخلية عن مركز الأفكار، كلما تعرضت بنيتها وفضاءها المعرفي الداخلي للتبدلات والتحولات، حتى تصل في بعض الأحيان إلى تغيير شامل لبنية الأفكار لتتوالد مدرسة فكرية جديدة، لكن نشأت من رحم تلك الأفكار الأم.
والمصلح المفكر إما يُخْضِع السياسيين لإرادته المعرفية، من خلال ما يكتسبه من سمعة معرفية رصينة تمثل قطب الرحى في عصره، ومغناطيس المفكرين والنخب، فتصبح سمعته الفكرية مستقلة عن الخدمات المقدمة له، فيزداد رصيده في المصداقية خاصة في محيطه الاجتماعي والمدرسي، أو أنه يوظف رصيده المعرفي في مدارات السياسيين ليدور في فلكهم، ليصطاد بصنارة أفكاره ما يحقق له مصالحه الذاتية، فتخضع بذلك أفكاره للخدمات المقدمة له، فتفقد استقلاليتها ومن ثم مصداقيتها الاجتماعية والمدرسية.
المصلح والاستحواذ الحركي:
الاستحواذ الحركي في مواجهة الفساد، هو فساد بذاته، يمكن للمصلح أن يميز حراكه في مواجهة الفساد عن الآخرين لاختلاف الأهداف والآليات، لكن لا يمكنه أن يستحوذ على الحراك، بحجة الاصلاح، ويستحوذ على الحق بأنه الأحق به، كما لا يمكن لمصلح حقيقي يثور على الوضع الفاسد، أن يبرر هتك كرامات وانتقاص حقوق خصومه المتورطين في الفساد، فالبينة على من ادعى، ولهم الحق في محاكمات عادلة حتى في لحظات الثورة، فمن الفساد أيضا الظلم، بل هو أشد أنواع الفساد، ولا يمكن للعدالة أن تتحقق بفساد الأدوات والطرق.
ولا يمكن لمصلح حقيقي ثائر يطلب تغيير الوضع الفاسد، بأن يرتكب جرائم قتل عشوائية بمن كانوا في النظام الفاسد، بحجة تثبيت دعائم الثورة، ولا يمكن التوسل بالفوضى واستخدام سذاجة الناس وعفويتهم، أو استغلال جوعهم وفقرهم في مواجهة الفساد القائم، واستعمالهم كوقود للمواجهة والمعركة ضد الفساد والاستبداد، وتعريضهم للقتل أو السجن دون أن يدركوا تبعات مشاركتهم وخياراتهم لذلك، ودون أن تبذل جهدا في شرح الواقع لهم وتبعات الحراك، وحجم التضحيات المطلوبة، حتى يكون لهم حرية وإرادة الاختيار.
لذلك الثورات النظيفة لم تبق غالبا وتنتصر بالمفهوم المادي للانتصار، وإن حققت نصرا استراتيجيا من خلال تثبيت منظومة القيم والمعايير لتصبح مرجعية معيارية من جهة، ومنهجا يشكل نموذجا من جهة أخرى.
على سبيل المثال الثورة الفرنسية مرت بمراحل عديدة، لكنها تسلقت على جثث أبرياء، وتعرضت كثير من معالم باريس للسرقة والتلف، بل بعض الثوار القياديين تورطوا أيضا بالفساد، بل ينقل التاريخ اعدام قيادات الثورة لبعضهم البعض تحت شعار الفضيلة والارهاب، فكان ينقل عن ماكسيل أحد منظري الثورة القانونيين أن الفضيلة بدون ارهاب ضعف، والارهاب بدون فضيلة ديكتاتورية، هذا فضلا عن حجم الضحايا الكبير من عموم الناس الفقراء والجوعى الذين سقطوا في معارك الثورة دون وعي منهم للتبعات. لكنها نجحت في النهاية من التخلص من الحكم الملكي، الذي اعتبر طاغوتيا، بل تعتبر الثورة الفرنسية الثورة التي غيرت وجه أوروبا.
لكن وفق معايير نجاح الثورات وقيامة دول حقيقية، هل فعلا فرنسا تخلصت من الديكتاتورية؟ وهل فعلا تحققت العدالة؟
إن حركات التغيير والاصلاح لا يمكن أن تنجح وفق معايير النجاح الحقيقية، إلا إذا تأسست على قاعدة ومنظومة ثابته من المعايير والمبادئ القيمية والأخلاقية، وجعلت مقاصدها العليا: حرية، عدالة، كرامة.
فالحرية لا يمكنها أن تحقق العدالة إلا إذا انضبطت هي بميزان العدالة، وتحرر الناس من كل أنواع العبوديات وأهمها عبودية الذات والشهوات، والعدالة لا تتحقق إلا إذا حققت الكرامة للجميع.
أما المساواة فهي فرع من فروع العدالة المنضبطة بها، لأن ليس كل مساواة تحقق العدالة، بل تكون في أحيانا كثيرة، هي الظلم بعينه.
كيف يمكن الموازنة بين القوة والفضيلة؟
القوة في التفسير المادي هي عقيدة عسكرية توظف إمكاناتها العلمية والعقلية والمالية، في سبيل تقويض أي مواجهة ممكنة لمبادئها وقيمها العليا، التي صنعتها وفق مقاييسها الخاصة، وتصبح الفضيلة خاضعة لمعيارية القوة، بالتالي مواجهة أي تمرد محق في سبيل المطالبة بالعدالة، مواجهة عسكرية تفرط فيها الجهات المختصة باستخدام فائض قوتها، هذه المواجهة تصبح فضيلة، ولا يمكن بشكل من الأشكال وصمها بالإرهاب.
بل تلبس هذه المواجهة العسكرية الضالة ثوب الفضيلة، فتصبح وكأنها الخلاص الإنساني الذي يروج له كل خدام هذه الفكرة وأصحابها النافذين، من المفكرين الداعمين للفكر الرسمي لهذه الدول ومؤسساتها.
وهنا ليس بالضرورة كل مواجهة وكل ثورة تكون محقة وناجحة، لكن الفكرة هي مواجهة أقل تعبير ورأي خارج الإطار الرسمي الذي ترسمه هذه القوى وأصحاب النفوذ، بطريقة عسكرية موغلة بالعنف باسم الفضيلة.
فما يسمى مثلا "بعقيدة الأمن الوطني"، لا تعني بالضرورة الدفاع ضد عدو خارجي، وإنما طريقة لجعل المؤسسة العسكرية بفائض قوتها في مواجهة العدو الداخلي.
والسؤال: من هو العدو الداخلي؟ وما هي المعايير التي تشكل مرجعية في تشخيص هذا العدو وتصنيفه؟ وما هي القوانين التي تحقق العدالة في مواجهة هذا العدو دون ظلمه؟
العدو وفق " مبدأ عقيدة الأمن الوطني"، غالبا هم النشطاء والمثقفين المبدئيين والنقابيين والنساء والرجال والناشطين في حقوق الإنسان، غير الداعمين لمبادئ السلطة وعقيدة المؤسسة العسكرية وفهمها للقوة، بالتالي يصبح استخدام القوة حتى المفرطة منها، في سبيل تحقيق الأمن الوطني " فضيلة"، ويتم بذلك تدجين الرأي العام والمؤسسات الاعلامية، لشرعنة استخدام القوة وفائضها بحجة "الأمن الوطني".
ولكن ما هو معنى مفهوم القوة خارج التفسير المادي الأحادي؟
القوة في بعدها المفاهيمي الآخر: هي عقيدة لامتلاك مكنة علمية وفكرية وثقافية وفلسفية صانعة لوعي الإنسان، تمكنه من تحرير ذاته من كل أشكال العبوديات، بحيث يصبح مالكا لإرادة القرار الحر، ومدركا لحجم التأثيرات الخارجية المحيطة، التي تعمل على توجيه إرادته ووعيه، ويمتلك أدوات في تفكيكها ومنع توجيهها لوعيه، فهنا هو صانع الحدث والتاريخ، وليس أداته ووقوده. وفي ذات الوقت يمتلك قوة عسكرية ليست للاعتداء واستغلال فائض القوة في الظلم والاستبداد، بل هي قوة دفاعية تحمي وجوده ومنجزاته الحضارية، قوة رادعة لأي اعتداء عليه أو هتك حرمته.
إذا هي قوة تحررية للعقل، والجسد، تمنع ذوبانه في منظومة الاستبداد، وتحويله لوقود في عقيدة الأمن الوطني المتحيزة للعسكر، وقود يحرق شريكه في الوطن، ليشكل حاجز صد لكل فكرة مغايرة، أو تحررية، أو محاولات مواجهة لتزييف الوعي.
في هذه العقيدة التحررية لمفهوم القوة، تحضر الفضيلة بكل ثقلها المعنوي، لتمنع كل محاولات تدجين الوعي، وتحويل مسار مفهوم القوة من بعده المادي والمعنوي، وحصره في البعد العسكري الذي يُفْرِط في استخدام فائض قوته، لمنع أي فائض في صناعة وعي الإنسان، أي فائض علمي ومعرفي، بل أي فائض حقوقي وإنساني.
الفضيلة هنا ليست في مقام تبرير القوة كما في "عقيدة الأمن الوطني"، بل هي في مقام قيادتها وصناعة معالمها، لتتشكل وفق معيار القيمة الإنسانية، التي تحقق كرامة الإنسان لا تسحقها.
وتصبح " عقيدة الأمن الوطني" خاضعة في معيارها لتحقيق الفضيلة، وأهم مصداق لها تحقيق كرامة الإنسان، فتمنع بذلك استخدام القوة ضد وعيه وتدجينه وفق رغبات السلطة، بل تصبح في خدمته لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ومنع أي محاولات اعتداء عليه، وعلى حقه في التفكير الحر، وحقه في الابداع وصناعة الحضارة.
فتصبح النخبة الحرة، حتى لو لم تكن خياراتها الفكرية كخيارات السلطة، تصبح في طليعة المجتمع، وتكون شريكته في صناعة وعي تحرري، يجعله شريكا أساسيا في القرار، ورقيبا ومحاسبا ومدققا في الحسابات والخيارات السياسية، بل حائط صد أمام كل محاولات تفتيت المجتمع، أو التمييز بين أفراده تحت أي مسمى، حتى لا تنجح السلطة وفق مفهومها الخاص للقوة، في الهيمنة على المجتمع والنخب الحرة والمصلحين لتحييد مفهومها للقوة.
فقوة السلطة استبدادية عسكرية تطويعيه، تستخدم الفضيلة أداة لتبريرها بشكل عصبوي متحيز، بينما قوة النخبة والمجتمع الحر، قوة تحررية تقودها الفضيلة نحو معيار الكرامة والحق الإنساني، دون أي شكل من أشكال التمييز.
ولا تستخدم هنا القوة العسكرية إلا في مواجهة أي محاولة لانتهاك كرامة وحقوق أي إنسان، فهي قوة تحمي الإنسان لا تهتك حرمته.
فهي قوة في خدمة الإنسان، لا خدمة السلطان وسلطته، هي قوة تقودها الفضيلة، لا فضيلة تقودها القوة، لتبرر هتك الكرامات بحجة المخاطر الأمنية التي تخضع لمعيار تشخيص السلطة المتحيز غالبا.