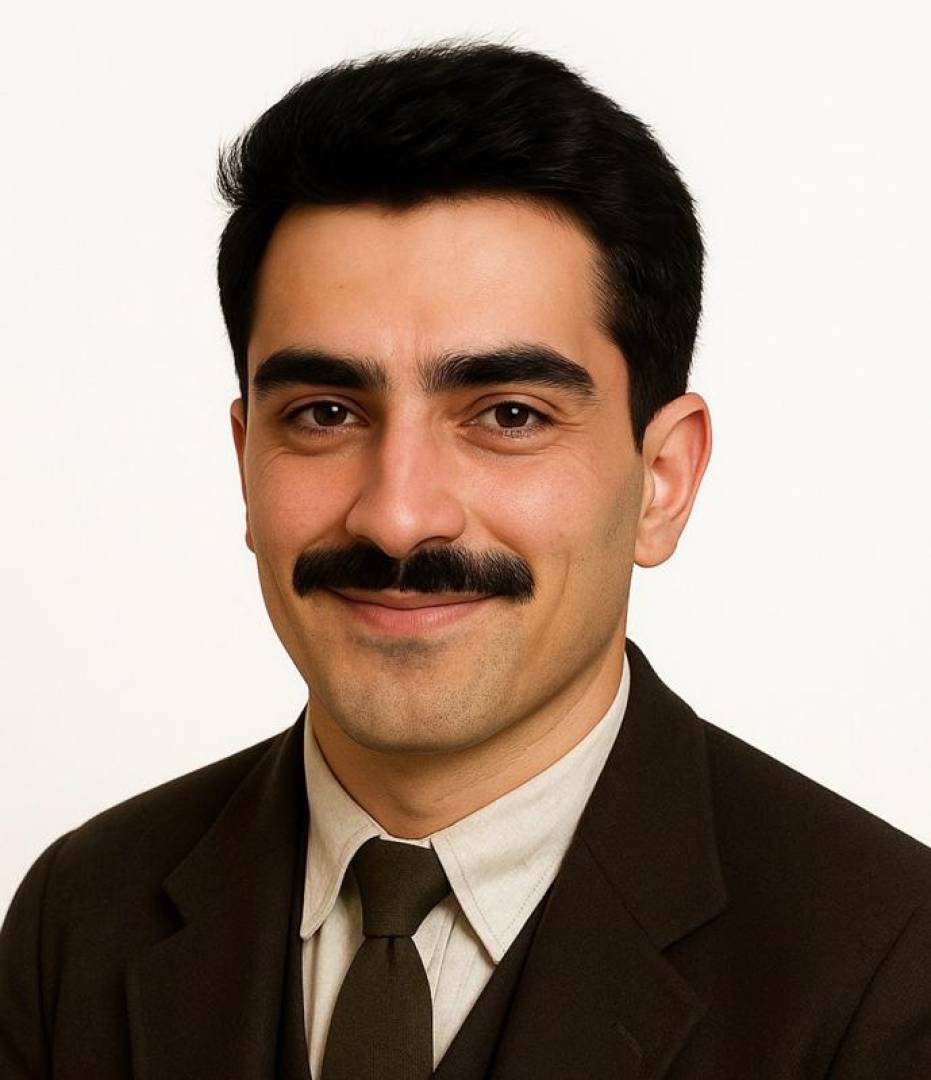لم يكن قرار مجلس الأمن الدولي برفع اسم رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات مجرد إجراء بروتوكولي عابر. إنه لحظة مفصلية على خريطة السياسة السورية والدولية، تحمل إشارات قوية، لكنها ليست خالية من الثمن والتحديات.
فمجلس الأمن لا يمنح مثل هذه التسهيلات بلا مقابل. التعاون القضائي، تبادل المعلومات الاستخباراتية، ضمانات أمنية، وربما التزامات دولية إضافية، هي العملة التي تقابل رفع العقوبات. هذا يوضح أن القرار ليس مكافأة، بل أداة ضغط وتحفيز في آن واحد، واختبار لقدرة القيادة الانتقالية على التعامل مع معادلات القوى الكبرى.
الامتناع الصيني عن التصويت لم يكن صدفة. بكين طالبت سابقا بربط القرار بملف المقاتلين الأجانب، لكن امتناعها يكشف عن تفاهمات خلف الكواليس، ربما لضمان تمرير القرار دون استخدام حق النقض، وربما لترك الباب مفتوحا لمساومات مستقبلية في ملفات حساسة.
القرار يمنح الشرع هامشا دبلوماسيا أوسع، ويتيح التعامل القانوني معه ومع خطاب المرحلة المقبلة، لكنه لا يمنحه أدوات ميدانية حقيقية لمواجهة التحديات الممتدة من البادية إلى الشمال الشرقي. هنا يكمن الاختبار الأكبر: هل ستتمكن القيادة الانتقالية من تحويل الاعتراف الدولي إلى استقرار فعلي على الأرض، أم سيظل رفع العقوبات خطوة رمزية ضمن لعبة مصالح القوى الكبرى؟
التساؤلات تتكدس:
ما هو الثمن الفعلي لهذه الخطوة؟
هل هو فقط داخلي، أم سيمتد إقليمياً حتماً؟
هل الهدف الحرب على داعش، القضاء على الجهاديين، المشاركة في عمل إقليمي، أم تقديم تنازلات كبيرة؟
أم أن الأمر سيقتصر على الحرب على داعش ومكافحة الجهاديين الأجانب فقط؟
هل سيكون التعاون الأمني الاستخباراتي والعدلي مع المجتمع الدولي جزءا من الصفقة الكبرى؟
ما جرى في شوارع دمشق — الألعاب النارية والاحتفالات الشعبية — يعكس ارتياحا مؤقتا، لكنه لا يغيّر حقيقة أن القيادة الانتقالية تواجه مرحلة اختبار حقيقية: بين الاعتراف الدولي وواقع الأرض المعقد، بين الرمزية السياسية والقدرة العملية على ضمان الأمن والاستقرار، وبين الأمل بالانفتاح والعقبات التي يفرضها التاريخ والمصالح الكبرى، وبين ثمن داخلي وإقليمي قد يمتد أثره على مستقبل سوريا والمنطقة كلها.