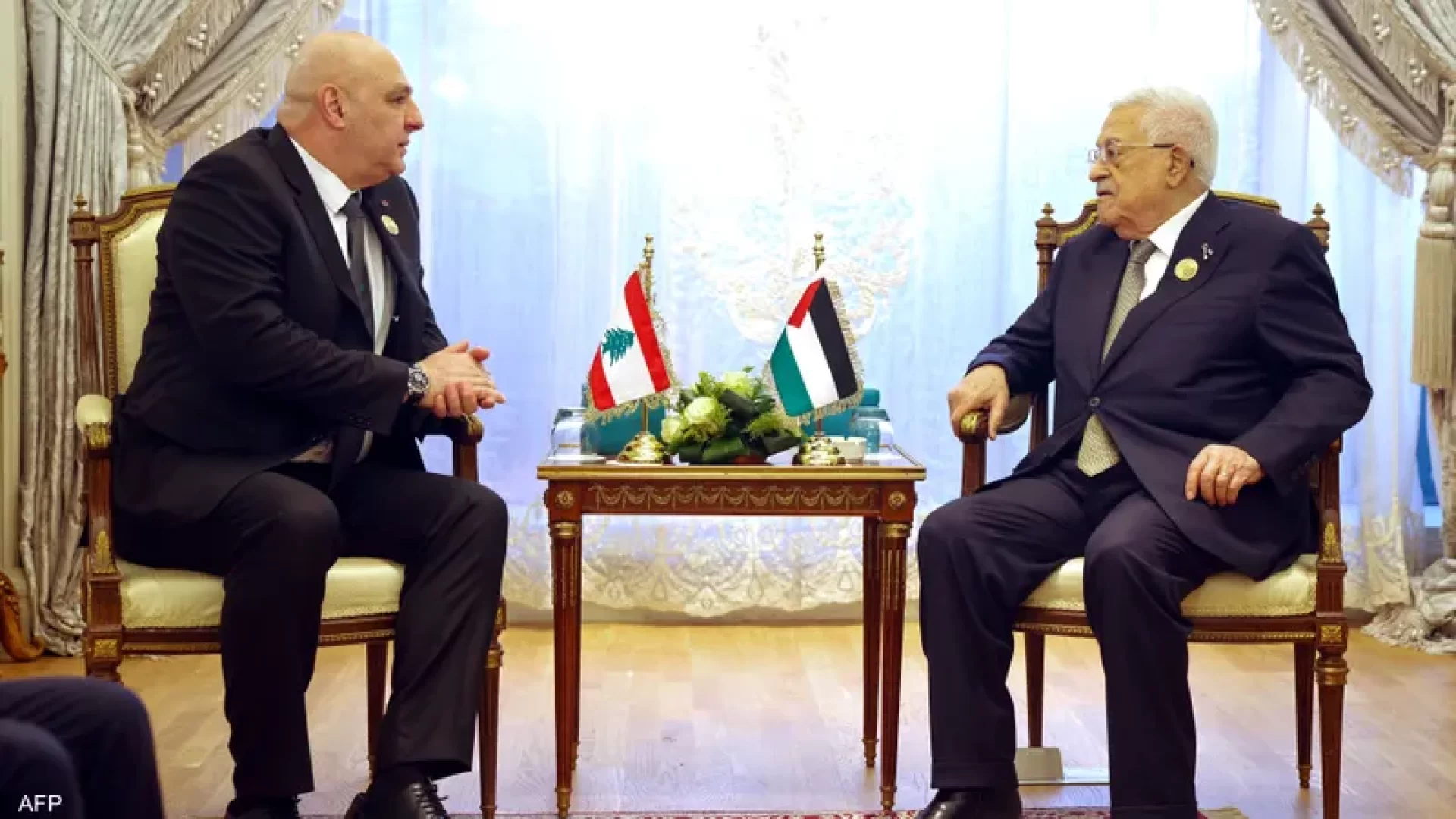كتب الكاتب حليم خاتون:
بين الثورة المؤجلة والثورة المخطوفة.. حرب أم حروب
لا يختلف اثنان على أنّ الأزمة الحالية الضاربة على كل الصعد في لبنان ليست أبداً أزمة مستجدة؛ بل هي أزمة موجودة في رحم هذا الكيان منذ ما قبل إيجاده، في صيغة دولة لبنان الكبير سنة ١٩٢٠.
فمن منّا لم يتابع،على مقاعد الدراسة، أوحتى في الأحاديث الشعبية قصص حروب الدروز بعضهم مع بعض، أو حروبهم مع الموارنة في ما سمي فتنة١٨٦٠.
إنّهم البشر. إنّهاالطبيعة البشرية الطمّاعة، التي تريد دوما كل شيء لها وحدها، فتدخل الحروب ضد الآخر. ليس مهماً من هو هذا الآخر.
العقل البشري كفيل بإيجاده. هذا موجود عند كل البشر، وأبسط مثال على ذلك هو تفتيش الأميركيين دوما عن عدو.
في الأمس البعيد نسبياً، كان عدو الأميركيين هم الألمان،ثم السوفيات، ثم الإسلام، واليوم صار العدومثلّثاً بثلاثة أضلاع: روسيا،الصين، وإيران.
وكما يقول المثل اللبناني:أنا وأخي على ابن عمي،وانا وابن عمي على الغريب.
في التاريخ اللبناني ما قبل الجبل، هناك تاريخ محكي أحيانا، وتواريخ مكتوبة؛ في كلٍّ منها شيء من الحقيقة، والكثير الكثير من التزوير؛ تمحيص هذه التواريخ ليس اليوم موضوعنا، رغم أهمية وجوب إعادة كتابة تاريخ لبنان الحديث، على الأقل، ليتناول تاريخ كل المناطق اللبنانية الموجودة اليوم ضمن حدود ما يسمى بلبنان الكبير.
اليوم، نتناول دولة الجبل وعاصمتها بعبدا، بقدر الإمكان من الاختصار.
لقد سكن هذا الجبل قبائل عربية أتت من شبه الجزيرة العربية بشكل أساسي مع مجيء الصحابي، أبو ذر الغفاري، قبل أن تنضم إليهم جماعات هربت من العراق وبلاد الشام، هربا من الاضطهاد الأموي لكل المعارضين الذين شكّل الشيعة القسم الأكبر منهم.
هرب الجميع والتجأوا إلى هذا الجبل والجبال الأخرى، حتى يكونوا في مأمن من الجيوش الأموية، فالعباسية،فالمملوكية، فالعثمانية؛ والتي اشتهرت جميعها باضطهاد الشيعة. لكنَّ شيئا حصل في هذا الجبل، تحديداً أثناء حكم الخلافة الفاطمية في مصر، التي احتضنت كل أنصار أهل البيت،
ومنهم سكان هذا الجبل.
وكان لدعوة أحد هؤلاء الخلفاء الفاطميين (لم يحضرني اسمه الآن)، كان لدعوته إلى مذهب جديد، تبعه أهل هذا الجبل وسموا منذ ذلك اليوم بالدروز نسبة إلى مبعوث الخليفة إياه، حيث كان هذا المبعوث يكنى بالدَرَزي.
كان لهذه الدعوة أبلغ الأثر في جعل هذا الجبل كينونة خاصة به.
وكما في قصص حام وسام، وقايين وهابيل، دارت حروب للسيطرة بين الدروز أنفسهم حيث انقسموا إلى حزبين:القيسيين واليمنيين..
كان الموارنة لا زالوا منتشرين في بلاد الشام، وكانوا يعملون بشكل أساسي في الزراعة, بينما كان معظم الدروز من الفرسان الذين يملكون الأراضي، ولا يجدون من يعمل فيها حيث كان العمل في الزراعةعيباً في العرف الدرزي.
قام الدروز باستقدام الموارنة للعمل في زراعة أراضيهم على طريقة"المقاطعجية".
وتكاثر عدد الموارنة، ومع تقدم السنين، صاروا جزءاً مُهِماً من البنية الديموغرافية لهذا الجبل.
وكما يحصل دوما في حياة البشر، انتفت الخلافات الدرزية الدرزية، ليبدأ عصر الخلاف الماروني الدرزي.
وككل الخلافات، يكون السبب دوما اقتصادياً حتى وإن ظهربأي مظهرٍ آخر.
تكاثر عدد المسيحيين مع استمرار توافدهم، من كل بلاد الشام والعراق، بينما صار الدروز أقلية؛ وهذا ما دفع بالصراع الاقتصادي، المصلحي أصلا إلى اتخاذ شكل صراع طائفي بين أقلية تحكم مع الأمراء المعنيين والشهابيين، وأكثرية تريد أن تدخل جنة الحكم.
انفجر هذا الصراع بين الطائفتين، في ما سمي يومها بفتنة١٨٦٠
وانتهى بتدخل الغرب بسبب ضعف السلطنة العثمانية، وإعلان نظام المتصرفية الذي كان من شروطه أن يكون المتصرف مسيحيا، ولكن من رعايا السلطنة ،شرط ألّا ينتمي إلى هذا الجبل.
استمر تعاظم النفوذ المسيحي وازدادت سيطرة المسيحيين على اقتصاد الجبل، في الوقت نفسه الذي ضمر فيه النفوذ الدرزي
ومع وصول سنة١٩٢٠، صار المسيحيون القوة الأولى، خاصة مع سيطرة فرنسا على الجبل، وكل المناطق التي تسمى اليوم لبنان.
في الحقيقة لم يكن لبنان فقط حاجة مسيحية، كما أرادت البطركية المارونية الإيحاء به, لقد كان حاجة فرنسية خالصة.
أرادت فرنسا تقسيم سوريا الى دويلات ليسهل حكمها، فقامت باقتطاع الشمال والجنوب والبقاع وبيروت، من بلاد الشام وضمتها إلى دولة أسمتها، دولة لبنان الكبير، لتضمن حكمها لهذه المناطق عبر الموارنة.
وإذا كانت الدويلات العلوية والدرزية والسنية في بلاد الشام قد رفضت هذا التقسيم وتوحدت فيما بينها لتشكل الدولة السورية المعاصرة؛ فإنالمسيحيين أوجدوا، مع بعض السنة وبعض الإقطاع الشيعي، تفاهمات لإبقاء هذا البلد خارج الدولة السورية.
تميزت الفترة بين ١٩٢٠ و١٩٤٣ والتي يمكن تسميتها بالجمهورية الأولى؛ تميزت بسيطرة البرجوازية المسيحية الآتية من أصول فلاحية، بالتضامن مع بقايا الإقطاع السنّي المديني، على حكم البلد، والإستئثار بثرواته ومقدراته...
ظلت هذه الصيغة سارية بعد الاستقلال، حيث من الممكن القول: إنّ الجمهورية الأولى استمرت مع سيطرة البرجوازية المسيحية نفسها، مع الإقطاع السني نفسه، بعد انضمام الإقطاعين الدرزي والشيعي إلى هذه الصيغة، مع إبقاء الأخيرين ضمن سلطة صورية لا غير.
ومع أحداث ١٩٥٨، ضد كميل شمعون، انتهت الهيمنة المطلقة
للمسيحيين الذين أفسحوا المجال لوجود شريك سني فاعل بفضل الثقل المصري.لذا يمكن تسمية هذه الجمهورية الثانية، بجمهورية الحكم الماروني أولاً ورئيسياً، والحكم السني ثانيا.
ظلّت البرجوازية المسيحية تمسك بكل مفاصل السلطتين: السياسية والاقتصادية وإن تركت الكثير من الفتات للبرجوازية المدينية السنية،
وبعض الفتات للإقطاعين الدرزي والشيعي.
وبرغم إصلاحات فؤاد شهاب في التنظيم الإداري للدولة، وإنشائه الكثير من المؤسسات لتكريس دولة القانون والتخلص من بقايا الدولة القديمة، إلا أن انتصار الحلف الثلاثي الماروني عليه أوقف عجلة الإصلاحات، وعاد لمحاولة تكريس دولة الطوائف ،بزعامة الطائفة المارونية.
لم يدم هذا الإنقلاب الماروني طويلا،بسبب التذمر الكبير الذي بدأ يخرج من الطائفتين الشيعية والدرزية، مع تضامن ضمني من الطائفة السنّية.
الصراع اقتصادي دائماً، وإذا أخذ بُعداً طائفياً، فهذا ليس سوى شكلٍ ، أو غطاءٍ صراعٍ طبقي مرير ،بين البرجوازية الكبيرة التي كانت بمعظمها مسيحية مع القليل من السنّة، ضد الطبقات المسحوقة التي كانت بمعظمها من الشيعة، الذين كانوا يفتشون عن مكان لهم تحت الشمس، يعاونهم في ذلك الدروز الذين كانوا بمعظمهم من الطبقات الوسطى والموظفين.
الطائفة الوحيدة هنا التي كانت منقسمة إلى قسمين كبيرين، هي الطائفة السنّيّة.حيث وقفت البرجوازية الكبيرة السنية إلى جانب البرجوازية الكبيرة المسيحية، في حين انضم المسحوقون من هذه الطائفة، من الشمال والبقاع خاصة، إلى رفض نظام هذه الجمهورية ما أدّى إلى اندلاع الحرب.
بل اندلعت حروب, كان بعض أسبابها، فعلاً أزمة هذا النظام.
ولكنّ بعض الأسباب كان مرتبطاً أيضاً بالقضية الفلسطينية؛ بوجوب توجيه الضربة القاضية لهذه القضية، وللمد القومي الذي ضعف كثيراً، مع غياب جمال عبد الناصر, زد على ذلك، طموح بريطانيا وإسرائيل، لإنهاء دور لبنان، وبيروت خصوصاً، لصالح نقل مركز الشرق الأوسط إلى الإمارات ودبي تحديداً...
فتش دوما عن الاقتصاد.
فتش دوما عن المصالح.
كان من المفترض أن ينهي غزو لبنان سنة ١٩٨٢، القضية الفلسطينية، القومية العربية، ودور لبنان المركزي.
ولكن الإمبريالية تخطط،
والله يساعد الشعوب على التدبير.
في الخمسينيات، أطاحت الإمبريالية بالزعيم القومي الإيراني، مصدّق، فجاءهم الشعب الٱيراني بالخميني والجمهورية الإسلامية التي تخطت مشاريعها وقوتها كل ما كان من الممكن لمصدق أن يفعله.
كذلك كان الأمر في لبنان.
ضربوا المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية التي كانت بالكاد تخدش حياء إسرائيل، فخرجت إليهم مقاومة إسلامية تهدد أساس وجود الكيان الصهيوني، وتتجذر كل يوم باتجاه ضرب كل الوجود الإمبريالي في الشرق الأوسط.
وفي سنة ١٩٨٢، انتجت مقاومة قوية وخطيرة دفعت الأميركيين للتفتيش عن مخرج.
ظن الأميركيون أنّ تشليح المسيحيين نفوذهم، مع الإبقاء على احتكارات البرجوازية الكبيرة، وإعطاء هذا النفوذ إلى السُّنّة المنضوين في كنف السعودية سوف يضع حداً لهذه المقاومة.
هل كان هذا الترقيع للجمهورية القديمة كافياً؟
هل تنهي جمهورية الطائف دور هذه المقاومة؟
كما قلنا: المشكلة مهما تغير شكلها، تظل اقتصادية مصلحية.
تداخلت الطبقات ضمن الطوائف.
لم يعد بالإمكان استمرار نفس النظام.
الإمبريالية تعرف هذا وهي لا تريد، لا من الشعب ولا من المقاومة، أن يعرفوا هذا.
هي تحاول الترقيع للاستفادة من الوقت.
هي تعرف أن آخر الدواء الكي.
تهددنا بالتدمير الكامل...
تهدد بالحرب.
بعضهم يخافها، هذا طبيعي.
ولكن ما الحل؟
كل يوم نُحشر أكثر وأكثر.
إلى متى يمكن الانتظار؟
نعم الحرب قادمة.
تجنب الحرب يعني أن نركع، ونسبّح باسم أميركا.
ألف سنة مرت ونحن نقاتل الغزاة الأوروبيين.
لم يستسلم أجدادنا.
ولن نستسلم نحن.
من يلتحق بالأعداء، يلتحق بالهزيمة.
هذه المرة لن تسامح المقاومة كما فعلت بعد حرب التحرير.
ربما المقاومة لم تستطع،أوقل لم تحاول بناء دولة القانون.لكنّ المقاومة أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر.
دولة القانون سوف تأتي بالتّأكيد.
الشرق سوف ينهض بالتأكيد.
ومن خلف كوادر الحرب، سوف يأتي كوادر بناء الدولة.
لا تخيفونا بالحرب.
كما تطورت المقاومة من مجموعات صغيرة إلى بحر هدّارٍ هزم حلف الأطلسي في سورية. كذلك سوف تهزم المقاومة كل أحفاد الأطلسي في المنطقة.
حتى لو فشلت هذه المقاومة، سوف تُنبِتُ الأرضُ مقاومات، إلى أن تستقيم الأحوال.
إنه الرهان.
نحن أو إيّاهم.
نكون أو لا نكون.
والأرض تقول:...بل سوف نكون.